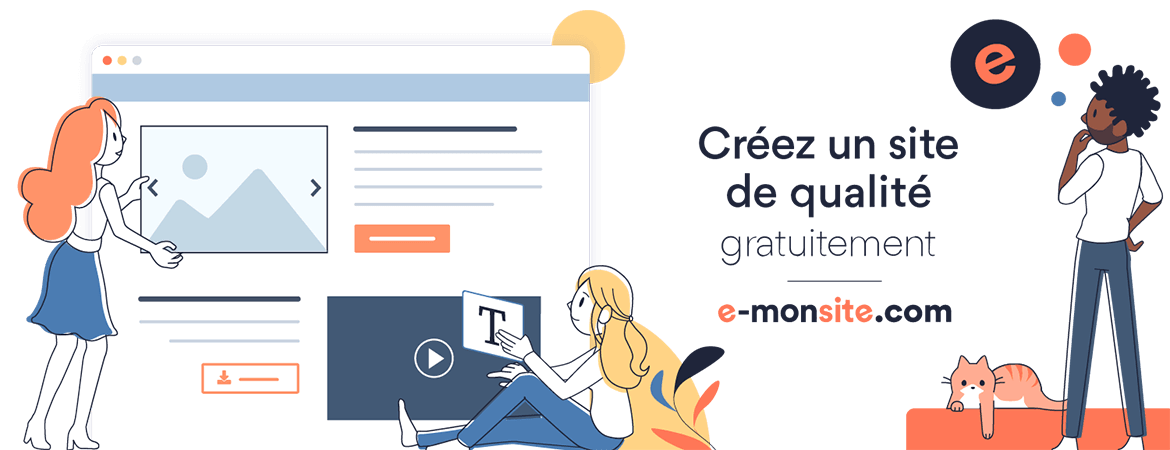قصتي مع الشِّعر

وبعد،
قد يجتهد الكاتب في الخلق فيُبْدع صوراً لم يسبق لمثلها، ويتأتّى له من الخيال ما يجتاز به مباذل الحياة اليومية وينسج البدائع والطرائف، ولكن ما لسان حاله ودأب جهده أمام وقائع ولّتْ واستحالت إلى رميمٍ وذرّات في نهر الزمن السحيق؟ هل استطاعت ذاكرته أن تحتفظ بألقها فأبقت له من شريط عمره، في السراء والضراء، ما يقدح زند مُخيِّلته متى شاء؟ كيف تظلُّ علاقته بمكانه الأول، لا سيما إذا هجره بغتةً، وهاجر إلى أمكنة أخرى كثيرة في الواقع والنفس؟ تلك بعض أسئلةٍ من فيض، ونحن نستعيد زمن الكتابة وتجربتها الأولى، مكانها الأوّل، روائحها وأطيافها وتخاريمها الأولى أَيْضاً، قبل أن تتشابك مع مصائر جديدة، وأفق جديدـ
إنّ الطفل الّذي كنْتُه لا يزال يسكنني، ولا تزال الطفولة مصدراً يثري كتابتي الشعرية، ولا تزال الأمكنة التي أقمْتُها وعبرْتُها تتراءى لي كنجماتٍ تُضيء طريق مخيّلتي لهويّة تتحوّل باستمرار، وتسند أبْنيتي النصّية، ليكون تأريخها جميعاً بشكْلٍ ما، تأريخاً لزمنيّتي وسرديّاتي في الحياة بما تذّخر من خبرةٍ ودم. وأنا أهشّ بعصا ترحالي على جهات الأرض، بعيداً عن مسقط الرأس لأعوامٍ طوال، أرى أنّ تلك القرية وما تلاها قد تحوّل إلى حالةٍ شعريّة تستعيد تلك الطفولة التي عشْتُها وتخيّلْتُها؛ فنحن كلما تقدم بنا العمر نظلّ مسكونين أكثر بالعودة إلى طفولتنا وعوالمها الثريّة التلقائية. هذا قدر الإنسان. وما دمنا نركض باتجاه الموت فلا بُدّ لنا من العودة للطفولة بأسباب الحنين إليها، لأنّنا عشناها ببراءتنا، وأنا أرى إليها الآن كما لو كانت فردوساً مفقوداً، حتّى وهي أشْبه بخراب كما ورد إليّ. هكذا يتحوّل البحث في الكتابة بجُمْلته إلى بحثٍ عن 'المكان' وفيه، ومن ثمّة يمكن النظر إلى الكتابة على أنّه جهْدٌ متواصل يضع الذّات أمام هويّتها الخاصة الّتي تتحدّد بمدى ارتباطها بـ 'المكان' او انفصالها عنه، فتتحوّل بالنتيجة من مُجرّد فنٍّ إلى سلاحٍ يتمكن الكاتب بواسطته من إعادة إنتاج الأشياء بما في ذلك الذّات نفسها؛ ثمّ أليست 'الكتابة هي وسيلة استعادة المكان'؟ وذلك بتعبير إدوار سعيد الّذي لم يُخْف مشاعر الارتياب العميقة التي انتابتْهُ، وهو يؤلّف 'خارج المكان' ـ سيرته الذاتية ذائعة الصيت والعطر ـ
استعادة تُضيء كنجماتٍ طريق مُخيّلتي:
بالنسبة لي، تأخذ الاستعادة، في الحقيقة، طعم الصّعْـق. إنّي بصدد مغامرة من يُعيد إحياء ما كان مَيْتاً، قلِقاً، مُرتجفاً من ريح المتاه، وبالغ الهباء إذا اقتصدنا في الوصف. تعود بي الذاكرة، الآن، إلى بادية نائية من بوادي دكّالة المترامية والمنسية، حيث فتحتُ عينيّ على عالمٍ أتخيّله أشبه بالسحر والخرافة: مساقط الماء، مواسم الحصاد الذي لم ينقطع، وما يعقبه من فرحٍ بالزواج والختان وسط أغاني العيطة وزغاريد النّسوة التي تخرق عنان السماء، صياح الصّبْية في الكُتّاب بآي القرآن، صرير أقلامهم على الألواح المرقوشة بهالات الصمغ، بيوتات الطين الواطئة التي تتحلّق حول فناء العائلة، فتنة الزّرابي الموشومة بأنفاس الحبّ والحياة، نبات الصبّار الذي يغمر الجميع بالغلال والظلال، ضباب الطرق المتعرّجة إلى السوق الأسبوعي كلّ أربعاء، خرق العوانس على شجرات التين طرداً للنحس، نداء النخلة السامقة من بعيدٍ وهي تحرس أنام القرية وأنعامها من اللصوص وقُطّاع الطرق. وفوق هذا وذاك، سذاجة الناس وغفلتهم تقرأهما من سحناتهم الناتئة التي تنمّ عن قسوةٍ وعراكٍ مريرٍ مع الوقت، أو مع الدنيا بتعبيرهم. فتحتُ عيني على هذا العالم الخصيب والقاسي في آن، وتشرّبْتُ مئات الأصوات والصور والمرويّات والتمثُّلات عمّا يحيط بي، تدريجيّاً. سمعتُ عن الله والشيطان بدون أن أفقه العلاقة بينهما، وانتبهْتُ إلى قصص الجنّ والعفاريت من أفواه الجدّات، وتساءلتُ مراراً هل سماء البادية تنتهي إلى حدّ، حتّى جاء مُهاجروها الأُوَل للتجارة أو للعمل فأخبرونا بأنّ هناك مدناً كبيرة وجميلة تزخر بما لذّ وطاب. وعرفتُ معنى اليتم وأنا صبيّ أرعى غنم الجدّ، ويُفْترى عليّ من امرأة العمّ، ويُنْظر لي بعيون الشفقة من كثيرين. كما شكوْتُ من العيِّ في سنّي تلك، ولم يُطلق الله لساني إلا بعد أن أُدْخلت 'الجامع'، وتهجّيْتُ بحروفه عزّ وجلّ، وزاد أن ختمْتُ 'السّلْكة' على يد الفقيه.
منذ ذلك الوقت، كنت أرسم على الأبواب والحيطان بالفحم أو الجير، وأقرأ الرسائل التي ترِدُ على الأهل من بعيد، وأحياناً أجتهد في كتابة بعضٍ منها، بخوْفٍ وزَهْو. وكنْتُ أطالع بحماسٍ ما تقع عليه عيناي من مِزَق الصحف والمجلات التي كانت تقذفُ بها الريح إلى القرية، أو ممّا كانت تُلفُّ بها الحوائج المجلوبة من السوق الأسبوعي، وأجدُ في ذلك إمتاعاُ ينمّي شعوري ويقدح مخيّلتي. وكان يتردّد على بيت الجدّ من خارج القرية، شيخٌ ذو لحية بيضاء يُدعى الشافعي، وهو ممّن صحبهم أبي وأنزلهم الحظوة في مجلسه، لا يمنعه ورعه أن يلاعبني ويمسح بكفّيْه على رأسي، مُتوسّماً فيّ النباهة وميْلاً إلى المعرفة؛ ولم يأخذ أهلي وأقاربي ذلك بجدّ، حتّى سمعوا عن أقرانٍ من بني عمومتي المتكرّشين، أنّ العربي الطيمومي، وهو صاحب رأيٍ بأحد الصحف الوطنية وكراماتٍ من داخل حلقته المشهودة بالسوق، قد تنبّأ لي بأنّي سوف أركب الطائرة كنايةً عن موفور النجاح والسعة، وذلك لعظم شأنها في ذلك الوقت. ولا أنْسى أنّي كنْتُ أُغْرم ببعض الفتيات راعياتٍ للغنم في الخلاء أو ملثّمات في الدروب يسحبْنَ عجائزهنّ قبل شعورهنّ؛ ولم يسمع لي وضعي ولا الأعراف الجارية في النّهار بالبَوْح بمشاعري الوليدة. كانت الأشياء تمرُّ أمام عينيّ باردةً وغامضةً، وكثيرٌ منها لم يكن يعني لي بأكثر مِنْ وَجيبٍ داخليّ.
ينْقُر البَرْد على أعتاب ورار
هكذا هي تبْرحُني في سُكون
ليْس تسْألُ عنّي الْمَدى كيْف أَصْبَح،
والْكاظمينَ الزُّهور، وصمْتَ الأُوَيْقات عِنْد الْمغيب
كأنّ أصابِعَ جدّي ـ الّذي لمْ تُصافحْ يدِي يدَهُ ـ
ألْقَمتْها الرّياحَ
فَجاء يُذرّر غرْبَتَه في الطَّريق
يُريدُ امْرأةً، وقطيعاً، وشاهِدةً على التَّلّ.
وقْتَ الْكلالَةِ أراها كما هي
يمشطُ غصَّتَها أهلُها الْبُسطاء..
حصادٌ
وتبْرٌ
وطِينْ
ما أجلَّك يا سِرُّ
ضاعفْ تلاوينَ رقْصِك
وانْسَ يديّ تُطالِعُ شَاهِدةَ الجَدِّ
صمْتاً
بِمرْأى الْغريبْ
النزوح إلى المدينة إذ تعثّرْتُ بشعر:
لحرص والدتي على تعليمنا وحسن تَنْشئتنا، حصل أن رحلنا عن قريتنا التي رأيْتُ فيها النور إلى المدينة ونحن فقراء إلّا من رحمة الله، بعد أن سُرق من الأمّ لغفلتها رِزْقُ الأب من بني عمومته، وكان قد ترك وراءه ثروة هائلة من التجارة التي امتهنها بعرق جبينه. في مدينة الخميسات، التي كنّا نعبر إليها في طريق طويلةٍ وشاقّة عبر مدن الجديدة والدار البيضاء والرباط التي كانت تشدّني وتقدح مخيّلتي كلّما اخترقْتُ شوارعها، وقفْتُ على معنى أن تكون مسؤولاً في أيّام العوز، قبل أن أشبّ عن الطّوْق. ربّتْ فيّ الحاجة الجدّ على حساب اللعب، وسرقت منّا البشاشة لصالح الحزم والتأمُّل في البعيد. ثُمّ سرعان ما طِرْنا ـ بما يُشبه الخلاص حقّاً ـ إلى بلدةٍ جميلةٍ اسمها سيدي علال البحراوي التي تقرب من الرباط شرقاً ببضعة كيلومترات. هنا، رعيْتُ بأمّ عينيّ وشغاف قلبي صور الجمال والبهاء والسحر في ما حبا الله هذه البلدة المخفورة بأشجار البلّوط السامقة والأضرحة العامرة من كثرة العيون ووفرة الغلّة وبسطة الحال بين ساكنتها. حرّرْتُ طفولتي المستلبة، وأشبعْتُ شغبي رفقة أقراني من الحيّ والمدرسة. وقد أتاح لي الصفّ الدراسي واجتهادي فيه أن أتعرّف، بعد كتاب الله، على كتُبٍ أخرى بما في ذلك المصوّرة التي كانت تقذف بي في أحلام اليقظة والعوالم العجيبة، مثلما واجهْتُ لأوّل مرّةٍ نصوصاً من الشعر في مادة المحفوظات، وتفتّقتْ موهبتي في موضوعات الإنشاء التي كنّا نُؤْمر بها، فأسرْتُ بمخيّلتي وخطّي الجميل أساتذتي وأضرابي في الفصل من الحسناوات والكسالى معاً. لمّا نِلْتُ شهادة الابتدائي، بعد ثلاث سنواتٍ من مقام الإمتاع والهناءة، عُدْنا أدراجنا إلى المدينة ذاتها، فجدّدْتُ عهدي بالمصاعب تحت وطأة الحياة وعوزها. لكنّ قدراً جميلاً كان بانتظاري في محطّة ما، بعد أن عاركتْني الحياة وزاد وعيي الشقيّ بها وقلّت الرفقة، إذ قادتْني يدايَ ـ لا أدري صُدْفةً أم هِبةً ـ إلى كتاب 'ميزان الذهب في صناعة أشعار العرب' الذي كان بمثابة كتاب مقدّس، ثمّ قادَتْني خُطاي إلى مكتبة، فاقتنيْتُ دواوين من الشعر ممّا يدّخر صاحبها منه، وكانت علاقتي بالشعر بدأت تتوطّد من سماعه وقراءته بين برامج إذاعية وملاحق ثقافية. أذكر أنّي اقتنيْتُ: ' رباعيات الخيام' بترجمة أحمد رامي، 'الملاّح التائه' لعلي محمود طه، 'الحياة الحبّ' لإبراهيم محمد نجا، 'الأجنحة المتكسرة' و'الأرواح المتمردة' لجبران خليل جبران. كما استعرت 'أغاني الحياة' لأبي القاسم الشابي، و'ديوان إيليا أبي ماضي'، و'ديوان بهاء الدين زهير'، و'أحلى قصائدي' لنزار قباني. وكنتُ أحمل معي هذه الدواوين، إلى جانب كتبٍ أخرى كنْتُ عثرْتُ عليها بثَمنٍ زهيدٍ في أسواق الخُرْدة، وضمْنَها روايتان لنجيب لحفوظ ومجلاّت متنوّعة ومراجع فلسفية وفكرية كانت محكّاً لعقلي قبل الأوان، إلى القرية النائية على رأس كلّ صَيْف، بعد فراغي من سنةٍ دراسيّة ثقيلة بنتيجةٍ مرضية كانت تسبقني وتوغر صدور كثيرين، إلاّ جدّتي من أمّي وعمّي الذي كان يُسرّها في نفسه مخافة من سخط زوجته التي لم تُحِطها إلاّ بأبناء مغفّلين يتجشّؤون بطعامٍ وسواه. كنْتُ أعتكفُ، طيلة الصيف، على قراءة الكتب بنَهمٍ، حتّى سمعْتُ من بعضهم أنّ ولد عبدالله به مسٌّ أو قد جُنّ. لقد فعلت فيّ هذه الدواوين فعل السّحْر، وقدحت ذهني، ووشمت وجداني، فصارت رؤيتي ـ نتيجةً لمقروئيّتي ـ رومانسيّةً وحالمةً ومتفائلةً.
مع ذلك، كانت حدود وعيي بالشعر لا زالت غائمة ومضطربة، بموازاة مع النزوع المدرسي الذي كان يُشيِّئ القصيدة ويُسطّح عمقها اللغوي والمجازي إلى حدٍّ فادح. مُعلّقات، قصائد ومقطوعات شعرية كانت تمرُّ أمامي عيني بدون أن تُثير فيّ إحساساً، ولا أن تحملني إلى مسافةٍ أخرى من الجمال والذوق. فقد كان مدرّسو العربية يتأفّفون من الشعر ويُكنّون عداءً خفيّاً إزاءه، ولهذا كانت حصة الشعر ثقيلةً ومُملّة وبلا معنى يُذكر، وبسبب ذلك غدا أقراني من تلاميذ السلكين الإعدادي والثانوي فالجامعي يكنّون العداء نفسه، بل يُجاهرون به. إنّ أيّ طالب بينهم يحسن إلقاء قصيدة، أو ينجزون عرضاً عن الشعر، أو يتدخّل برأي جمالي فيه كان يضع نفسه في موقف لا يُحسد عليه من السخرية والتنكيت، فلا يعود إلى ذلك مرّة ثانية. لم يكن الأمر يتعلّق بجيلي، بل بأجيالٍ سبقت وأخرى أتت تالياً. عداءٌ مستحكم، بالفعل.
ولولا قدماي اللّتان ساقتاني إلى دواوين خارج الفصل الدراسي وإكراهاته، ولولا حاجة إلى تعويض كنْتُ أحِسّه بداخلي، لما وجدْتُ نفسي بينهم ناقماً على الشعر وأهله. كانت ساعاتي بين الدواوين الأولى ساعات حبّ وإصغاء وتعلُّم وصفاء، ثُمّ سرعان ما استحال ذلك إلى أجنحة أطير بها وأُغنّي من الحرمان، وعلى شفاهي هذا البيت الشعري لأبي ماضي:
الشُّجاعُ الشُّجاعُ عندي من أَمْسى يُغنّي والدّمْـــعُ في الأجفانِ
في ضيافة نزار قباني:
كان الديوان الذي زلزل فهمي للشعر وأراني العالم بوجْهٍ آخر، وأنا بعدُ على مقاعد السلك الثانوي، هو ديوان "أحلى قصائدي" للشاعر السوري نزار قباني الذي كانت شهرته، وقتئذٍ، تطبق الآفاق. الديوان عبارة عن كتاب جيب يسهل عليّ حمله أنّى حللتُ وارتحلت، وكان بمثابة مختارات شعرية جمعها الشاعر وصدّرها بتقديم جاء في بعضه: " أحلى قصائدي! هل هذا ممكن؟ وهل يستطيع شاعر على وجه الأرض أن يقرر بمثل هذه السهولة والرعونة، ما هي أحلى قصائده. وإذا كانت القصائد التي اخترتها هي أحلى القصائد من وجهة نظري، فهل هي كذلك بالنسبة للآخرين؟(...) إن فكرة إصدار مختارات شعرية لي فكرة قديمة ولكنني كنت دائماً أؤجّلها وأخشاها كما يخشى المتهم قرار المحكمة. إلا أن مواجهتي اليومية للجمهور ووقوفي أمامه فاعلاً ومنفعلاً وردود الفعل المختلفة التي كانت تواجَه بها قصائدي أكسبتني بعض الخبرة في معرفة القصائد ـ المفاتيح في شعري. وأعني بالقصائد ـ المفاتيح تلك القصائد التي تركت وراءها أسئلة.. وحرائق.. وناراً.. ودخانا. واليوم وقد قررت أن أدخل قاعة المحاكمة أود أن أهمس في آذان المحلفين أن اختيار بضعة أشجار من غابة لا يمثل حقيقة الغابة، وأن قطف ثلاثين زهرة، ووضعها في آنية.. فيه ظلم كبير للبستان".
في الحقيقة، اختار نزار قصائده التي تُمثّله ليس في تاريخه الشعري فحسب، بل في المخيال الجماعي الذي أدمن شعره أيّما إدمان. لقد عكست القصائد ظروف الشاعر التاريخية والنفسية والإنسانية التي كتبها تحت تأثيرها، وبالتالي كانت فكرة المختارات استراتيجية وكلمةَ سرٍّ وجواز سفر أمميّاً، في وقت حاسم من تجربته الشعرية. هذا الكلام لم أفهمه إلا لاحقاً، أمّا ما كان يستأثر باهتمامي ويستحوذ على مشاعري هو الموضوعات التي هرّبت أحلامي من مقصورة الرومانسيين وجعلتها في تماسّ مع الواقع ومحكّه اللاهب الذي كان يغلي في بداية التسعينيّات، قبل أن ينصرف اهتمامي إلى اللغة المتوتّرة الجذّابة التي كتب بها نزار، والإيقاع الذي عزف عليه شعره بنمطيه العمودي والتفعيلي مسموعاً وقويّاً. كانت قصيدة (اِختاري) فاتحةَ القصائد المختارة، وكلّما أشرعت دفّتي الديوان أتاني صوت نزار ثائراً ودافئاً، وحملني خياله الآسرُ بعشقه وحزنه وجنونه، وتارةً بزهده وكبريائه وهمومه. وتتوالى القصائد إذ يناصر نزار المرأة، ويتحدث عن الحبّ بمرارة، ويقلب أوجاع التاريخ ويسقط الأقنعة عن رجالٍ لا سياسة لهم، كما يتحدّث بشبوب عاطفي عن الأندلس وأبيه وأمه وطوق الياسمين الدمشقي. لا أزال أذكر قصائد "نهر الأحزان"، "حبلى"، "القصيدة الشريرة"، "الخرافة"، "خبز وحشيش وقمر"، و"الحب والبترول" و"الرسم بالكلمات". كما أذكر قصيدته "غرناطة" التي آذتني في الصميم، واستهلّها بقوله:
في مدخل الحمراء كان لقاؤنا ما أطيب اللُّقْيا بلا ميعاد
عينانِ سوداوانِ في حِجْريهما تتوالدُ الأبعادُ من أبعادِ
هل أنتِ إسبانيّةٌ؟ ساءلتُها قالتْ وفي غرناطةٍ ميلادي
غرناطة؟ وصحَتْ قرونٌ سبعةٌ في تينك العينينِ بعدَ رُقادِ
لقد أثر فيَّ نزار بمختاراته الشعرية، أوّلاً بعنايته بالإيقاع الذي ينطلق محسوساً ومرئيّاً، وثانياً بتشخيصه الحيوي للغة التي لا تحول مجازاتها دون التعبير عن جوهر الفكرة الشعرية بوضوح، ولهذا أفخر أنّي تعلّمت من نزار وأخذتُ عنه العمل على الشعر وسياساته.
الشِّعر ضرورة:
لقد أحسسْتُ في قرارة نفسي، بعد سنواتٍ من اغترابي النفسي والوجودي، أنّي عثرْتُ على أصفيائي من الشعراء من هؤلاء وأولئك؛ فقرأْتُ ما خطّوه بكلّ جوارحي، وذرفت معهم دموع هذه التجربة أو تلك، وارتفعْتُ وإيّاهم إلى مدارج الحلم والخيال. ثمّ، فجـأةً، كتبْتُ البيت والبيتيْن، حتّى استوت غيْمةُ الحال قصيدةًـ طيلة هذه الأيّام التي لا تُعدّ بغير ألسنة النّار ومشاغلها في الذّات، أستضمر الواقع والمجاز والمقدّس جنباً إلى جنب، حتّى أتت الكتابة في زخم الحياة، فأنقذتْني!
وهكذا، فإنّ ما أذكر عن لقائي بالشِّعر أنّهُ تمَّ في لحظة متوتِّرة من وعيي بالحياة وشرطها الإنساني. لنقُلْ كان نداءً هامساً وحاسماً من عبوري ذلك الوعي بما يشترطه من انتقال وجدانيّ ـ ذهني بين الأمكنة المتعيّنة والمحلوم بها، في لحظة من زمنٍ مشدود بسؤال الكينونة.
لم يكن التعليم وطرق تدريسه العقيمة والجافّة للأدب، كما أومأْتُ إلى ذلك، يُحيطني بهذا الوعي أو يُرشدني إليه، لولا انفتاحي على خارجه حيث كتب الشعر اليتيمة تٌناديني، من أمكنةٍ أخرى، على صبواتي الوليدة من الحبّ إلى معاناته بما في ذلك معاناة صوغه لغويّاً. لقد بدأ تاريخ كتابتي للشعر في هذه اللحظة التي أحسسْتُ فيها برغبة عارمة وغامضة في التعبير كأيّ شاعر وجد نفسه في حياة صعبة أعزل إلا من لواعج سريرته. لا أقول إن المصادفة هي التي قادتني إلى القصيدة، بل الضرورة التي تتغذّى على شرطنا الإنساني، وأفكر في جان كوكتو وهو يصرخ: "الشعر ضرورةٌ، وآه لو أعرف لماذا! ". في هذه الضرورة وجدت نفسي متورّطاً في ضيافة القصيدة، أقترب منها وأُعانيها. أذكر الآن كيف كانت تلك الأيام الأولى لكتابة القصيدة تتقاسم معي عمري الجميل والصعب في آن، والتي كان عليّ أن أتعلّم آداب ضيافتها منذ تلك اللحظة.
بعدما كانت في الأوّل رُومانسيّةً غالباً، صارت قراءاتي للشعر العربي تتنوَّع بين القديم والحديث، فتعرّفتُ على سحر الجاهلية، وحداثات المتنبي وأبي تمام والمعري العابرة للأزمنة، ورقّة شعراء الغزل في نسج رؤاهم للحبّ ومعاناته، وفيما بعد ـ تحت شعورٍ بالعجب والصدمة ـ تعرّفتُ على حيويّة الشعر الحر في عبوره إلى العصر وحداثته ونهوضه بمتخيّل شعريٍّ جديد، وعلى مفارقات محمد الماغوط وأمل دنقل ومظفر النواب وأحمد مطر الساخرة في نقد الواقع السياسي والاجتماعي، وعلى شعريّات محمود درويش وسعدي يوسف وأدونيس وقاسم حداد وأنسي الحاج وسركون بولص العابرة بالشعر العربي إلى الكونيّ. كذلك تأثّرت باختيارات الشاعر من أصول فلسطينية وجيه فهمي صلاح والشاعر محمد بنعمارة في برنامجيهما الإذاعيين "مع ناشئة الأدب" و"حدائق الشعر"، حيث يُلقى الشعر شفويّاً، ويتصادى مع صوتي اليتيم. وأمّا حظّي من الشعر المغربي فكان ضئيلاً، إلّا ما وقع بين يديّ ممّا كان يُنشر متفرّقاً من شعر شعراء غذّوا في نفسي شعوراً بهويّتي الجريحة، من أمثال محمد الحلوي وشاعر الحمراء محمد بن إبراهيم وأحمد المجاطي وإدريس الملياني، وإن كانت أشعار فنّي "العيطة" و"الملحون" الأصيلين أبلغ في وجداني؛ ثمّ سرعان ما انفتحتُ على الشعر الفرنسي وسواه من أشعار العالم مترجمةً إلى العربية، ولاسيما في مجلّتي "لوتس" و"الكرمل".
قصائد أولى من العزلة:
مع ما كان في نفسي من ميل شديد إلى العزلة، ونفورٍ غير مفهوم من عامّة الناس، إذ كنتُ أختلي لساعاتٍ طويلة بذاتي، تحت هذه الشجرة، أو على مقعد من مقاعد إحدى الحدائق العامة التي كانت تنعم بها مدينة الخميسات قبل أن يزحف عليها الإسمنت. أقرأ وأخطّ مقولات جُرْحي الأوّل مجازاً، وأعاني من أجل التعبير عن ذلك بتمارين لغوية وإيقاعية كثيرة. ولا زلتُ أذكر أنّ خطّي أثار لغرابته وصغر حجمه أنظار زملائي وأساتذتي وأفهامهم، فكانوا يتجشّمون العناء لقراءة ما أكتبه، وفكّ رموزه، وكأنّهم حقيقةً أمام طلاسم ورُقىً سحريّة، وليس أمام قصائد أولى لشاعر ناشئ كان يكتبُ ما يردُ عليه بارتعاش غامض. لكنّني سرعان ما اكتشفْتُ أنّي ليس الوحيد الذي أسره فنّ الأدب أو أغوَتْه ربّة الشعر، وأذاقته لذاذاتهما المعذِّبة، فقد وجدْتُ بين زملائي في الثانوية من انتهى مصيره إلى مصيري، وكابد مكابدتي. فقد تعرّفْتُ، على الأقلّ، على لفيفٍ منهم ممّن ضاق ذرعاً بدروس الثانوية الطويلة والمملّة، وكان يسترق الوقت لإشباع موهبته الأدبية في كتابٍ أو في مجلس من المجالس الأدبية التي كُنّا نعقدها فنناقش هذه القضية، أو نتحاور حول هذه الظاهرة، أو نتذوّق هذه الصورة أو اللطيفة ممّا كان يغدقه علينا الأدب شعره ونثره. ولم تكن مناقشاتنا تخلو من اختلافٍ في الرأي أو الذّوْق، بل كُنّا نجد في ذلك دليلاً على بداية نضجنا الفكري. كان بعضهم اتّجه إلى كتابة القصّة، والآخر إلى إلى فنّ التمثيل داخل فرق مسرحية هاوية، والثالث ممسوس بشيءٍ اِسْمُه الشعر. لكن كثيراً من هؤلاء من طلّقَ، لاحقاً، مزاج الأدب بعد توجُّهه إلى دراسة الحقوق أو العلم الشرعي، أو نتيجة انشغاله بأمورٍ معسرة. كنْتُ أحد القلّة الناجين، وإن كانت ظروفي أعسر، وذات يدي أضيق، غير أنّ شغفي بالشعر كان لا يُعادله أيُّ شغف، إذ وجدتُ فيه مُعادلاً لليتم الشخصي والإنساني الذي عانيْتُهُ منذ صباي.
كانت اختياراتي الشعرية، والتزامي النمط العمودي في بدايات كتابتي الشعرية، ودفاعي عنهما باستماتة وفهم، لا يُرْضي أكثر هؤلاء. فكان يُلقّبونني، لمزاً وغمزاً، بألقاب الشعراء المشهورين من القديم والحديث. الحطيئة. البحتري. الشابي. السياب. أمّا أنا فقد كنتُ أشعر بالفخر عندما يرنُّ أحد هذه الأسماء في أذني، أو أقيس-وهماً- قامتي بقاماتهم الباسقة.
كانت أولى قصائدي عموديّةً تُذاع على أثير الإذاعة الوطنية في برنامج "مع ناشئة الأدب" الذي اشتهر به الشاعر المغربي إدريس الجاي، قبل أن يتولّاه بعد رحيله الشاعر من أصل فلسطيني وجيه فهمي صالح. كان وجيه يقدّمني على غيري ويثني عليّ ويضرب المثل بي في بروز الموهبة. مثّل ذلك بالنسبة لي حافزاً على المضيّ قدماً في درب الكتابة وتطويرها، مثلما افتضح أمري كشاعر بين أصدقائي وأفراد عائلتي، وأنا الذي اعتبرْتُ الشعر حالة فرديّة خاصة يُكتب بمنأى عن أعين النّاس وفضولهم، إلّا أنّه في الحقيقة أشعرني بالزّهو والتفرُّد. كانت إحدى القصائد غزليّةً عنونتُها بـ (يا مُنْيتي)، وفيها سكبتُ أنفاس هواي الجريح، ولمّا سُمِع إليها يوم كان للإذاعة شأنٌ عظيمٌ، اعتقد النّاس أنّي نظَمْتُها تَغزُّلاً بفتاة كانت تدرس معنا في الثانوية نفسها، تُدعى "مُنْية"، وأنّي أريد بذلك التقرُّب إليها والظفر بها. ذاع الأمر في الثانوية، وعلمت به الفتاة، وووجدْتُ حالتي بين رجاء وخوف، لكن "شيطنة" بعضهم للقصيدة، وتحاملهم عليها، حمّلَ معناها ما لا تحتمل.
من بيت إلى بيت:
لم يكن بالمدينة متنفّسٌ ثقافيٌّ عموميٌّ لنحضر فعاليّاته بانتظام، أو لنقرأ إبداعنا ويستمع إلينا ساكنتها من جمهور الأدب على ضآلته، سوى "دار الشباب" التي لم تكن تُقدّم منتوجاً أدبيّاً رفيعاً إلا لماماً، لسوء الإدارة وتهافت أكثرهم على تأسيس جمعيّات أو نوادٍ لا علاقة لها بالثقافة والأدب. لكن البناية التي شدّت انتباهي، وشدَدْتُ رحلي إليها، هي بناية ملتقى الثقافات-اليونسكو التي كان يديرها الشاعر الزجال محمد الراشق. كانت منارةً ثقافيّةً قلّ أن أدَّت نظيراتها من المؤسسات العمومية ما كانت تضطلع به من العمل الثقافي والجمعوي لسنوات، يزدهر حيناً ويخفت حيناً آخر؛ فصارت محجّاً لأدباء ومثقفين مغاربة فعلت محاضراتهم عن الشعر والرواية والمسرح السينما والملحون في شبابها فعل السحر، وهم الذين نبغوا في تحصيلهم الدراسي وظلّوا يتوقون للإفصاح عن مواهبهم بلا طائل، بعدما تميّع النشاط الثقافي، وآلت الأمور لتدبير الثقافة، بين مؤسسة وأخرى، لغير أهلها ممّن كان وكدهم الدنيا وهمّ الوصولية. تتكوّن البناية من طابقين، أرضي للتنشيط الثقافي، وعلوي للسكن الإداري. يفصل بينها وبين الثانوية التي التحقت بها للدراسة أواخر الثمانينيات شارع عامّ، وفي الأطراف غابة بأشجار الكاليبتوس العظيمة، تتوسّطها كنيسة أثرت عن حقبة الاستعمار الفرنسي. وترافق تردُّدي على البناية والسياحة بلا وقت في الغابة مع بداياتي الشعرية، ولمّا علم سي محمد ذلك من بعض زملائي، إذ كنتُ أخفي تعاطي الشعر كمن يتعاطى إدمان شيء خطير، حتى أنزلني بين أترابي منزلة خاصة، وحرص على أن يشركني في أيّ نشاط يشرف عليه. في هذه البناية، تعرّفتُ على الشاعر بنسالم الدمناتي والكاتب المسرحي عبد الكريم برشيد، وعلى جيل جديدٍ من الكُتّاب يتلمّس طريقه وقتئذٍ. لاحقاً، سوف أتعرّفُ على قلّة شعراء أنشأنا، معاً، مجلّةً شعرية سمّيناها (دبُّــــوس)، صدرت منها أعداد قليلة في شكل كراريس، وضمّت بين دفّاتها نصوصاً لشعراء شباب من المدينة وخارجها، كانت ناطقة بحساسيّةٍ جديدة.
بعد انتقالي إلى الجامعة لاستكمال دراستي العليا، من مدينة القنيطرة إلى الرباط العاصمة، ثُمّ التحاقي بالمدرسة العليا للأساتذة وتخرُّجي منها مُدرّساً للغة العربية وآدابها، فتعييني ببلدة "ماسة" الأمازيغية جنوب مدينة أغادير، سكتُّ عن الشعر ردحاً من الزمن إلّا ما كان من تمارين شعرية كنتُ أحتفظ بها لنفسي. لكنّ قراءتي عن الشعر زادت بكيفيّةٍ مُكثّفةٍ فتحت أمامي فهماً جديداً عن خواصّه وقضاياه واتجاهاته. ذلك ما جعل شعري ينتقل بسلاسة، وعلى مراحل متراكبة نسبيّاً، من الأسلوب العمودي إلى الأسلوب التفعيلي، ومنهما إلى قصيدة النثر. وسوف ينعكس ذلك الانتقال بين أشكال الشعر على موضوعاتي، ولغتي، وإيقاعي، وأبنية تركيبي، ورؤيتي للعالم. وظلّت قصيدتي تغنم الصمت، ومعه الإصغاء إلى الأشياء بعمق، حتّى ظهرت نصوصي الشعرية الثانية، بعد الأولى على أثير برنامج "مع ناشئة الأدب"، على صفحات جريدة "القدس العربي"، التي كانت تصدر من لندن، ويشرف على قسمها الثقافي الشاعر الأردني أمجد ناصر، وذلك ابتداءً من خريف 2005م. بدت النصوص مختلفة عمّا سبقها لغةً وإيقاعاً ورؤية، وقد تَشكّل من معظمها ديواني الأول الذي خرج للوجود في السنة نفسها.
ديواني الأوّل، أو الوعد تحت طائلة الأحزان:
منذ أن تفتّقتْ ملكتي وشرعتُ في نَظْم الشِّعر، وأنا دون العشرين من عمري، كنتُ أحلم أن يصدر لديوانٌ. ديوانٌ لي مدبوغاً بحرّ أنفاسي، وعليه صورتي واسمي، إسوة بالشعراء الحديثين الذين بدأتُ أقرأ لهم. كُلّما تأخّر الحلم عن التحقٌّق، عاماً بعد عام، مثّل ذلك بالنسبة لي حافزاً للإصغاء إلى يفاعة تجربتي وتطويرها باستمرار، مثلما مثّل توُّرطاً، قاسياً وغير مفهوم، في الشعر الذي يُنادي عليك من أمكنة بعيدة. كان الحلم، في أحيان كثيرة، يتحوّل إلى يوتوبيا، ولاسيما في بلدٍ لا مكان فيه للشعر والشعراء تحت الشمس، مثل المغرب. والّذي أذكره، قبل أن يُطبع كتابي الأوّل، أنّ هناك مشاريع كتب دالّة كنتُ أصمّمها بنفسي وأضع أغلفتها وعناوينها بمناسبة أو بدونها، ثُمّ سرعان ما ضاعت منّي إلى الأبد. كان ديوان 'عرائس الصبا' الذي جمعتُه وأنا طالب في الثانوية، هو كتابي الأوّل حقّاً؛ ففيه آثارٌ مجروحة ٌبأنفاس حبّي الأوَّل، ومتاع ذاتي الشحيح، ودهشتي الأولى بالأشياء والعالم، كما نثرتُها في قصائد وجدانية وعاطفية، منظومة بين شكلي القريض والموشّح. كان مجمل هذه القصائد قد أُذيع في برنامج 'مع ناشئة الأدب' الشعري. لكن هذا الديوان الذي هيّأْتُه للطبع، وأرسلْتُه إلى البرنامج بعدما سمعْتُ ـ أنا وآخرون ـ وَعْـداً بذلك من مُعدِّه الشاعر وجيه فهمي صلاح، لم يكن إلّا حلماً في الكرى، ولا أعرف أين هو الآن؟
هكذا، بعد عقد ونصف من ملازمتي الشِّعر وعذابه، وبعدما لم يتحقّق الوعد من أيّ جهةٍ، ظهر كتابي الأوّل مطبوعاً على نفقتي الخاصّة التي دبّرتُها بِدَيْنٍ مع شقّ النفس، في أواخر العام 2005. كان عنوان الديوان في بادئ الأمر هو 'فراديس العزلة'، ثُمّ استقرّ رأيي، بمشورة صديقي الكاتب محمد بازي، على عنوان أكثر دلالةً: 'لماذا أشْهَدْتِ عليّ وعد السحاب؟'. بعد الطبع، بدأت قصّة توزيعي للديوان، بغلافه الأبيض الذي تخترقه صورة تجريديّة لصديقي الرسام محمد حستي، من مكتبة إلى أخرى، ومن كشك إلى آخر؛ ولمّا كان أصحابها يعلمون أنّي أحمل إليهم شعراً، يرفضون استلام النُّسخ منّي، أو يأخذون أقلّها بمضض، تحت نظرات الفضوليّين المشفقة، بذريعة أنّ الشعر بضاعة كاسدة.
لقد آلمني أن أسمع مثل هذا الكلام أكثر من مرّة بما يشبه إجماعاً. ساعاتٌ طويلةٌ قضيْتَها في الشعر وعلى حوافّه تبدو لك كأنّها هباء. وُوجِهْتُ بمثل هذا السؤال: هل أستمرّ في الكتابة أم أنقطع عنها إلى شأنٍ آخر؟ ـ لكن سرعان ما انفتح أمام عينيّ أفقٌ مثل هِبة، حيث وجدْتُ نفسي، داخل الثانوية التي أعمل بها، مُحاطاً بِتلقائيّة تلامذتي ودهشة عيونهم المُشعّة وانطباعاتهم العفويّة عن ديواني الذي ناقشوني في لغته وفضاءاته، وأثارهم ما وجدوا فيه من حزن، فتأثّروا بذلك جميعاً. صار الشعر، من هذه اللحظة بالذّات، التزاماً إنسانيّاً لا رجعة عنه. وأمّا الذين قرأوا الكتاب، من أصدقاء ونقّاد، فقد أثارهم تصميم الكتاب، ولغته، وغموضه المُشْبع بالرمز والخيال، مثلما بالجوع والخيبات. لكن أنّى لهم أن يعرفوا أنّ "وعد السحاب" لم يكن، في حقيقة الأمر، كتابي الأوّل، بل كان استئنافاً للوعد باللُّغة ومعنى الذّات. ضمّ الديوان بين دفّتيه حوالي أربعة وعشرين نصّاً شعريّاً متفاوت الطّول. كانت النصوص التي اخترتُها كُتِبتْ في خضمّ السنين الخمس الماضية، ونُقّحتْ ورُتّبتْ في خريف 2005م، وهي تنتسب إلى شعر التفعيلة وقصيدة النثر معاً. وممّا جاء في كلمة صديقي الناقد رشيد يحياوي على ظهر الغلاف: 'تفتح اللغة في هذا العمل موطنها لمأساة عارية (...) وكأس الشاعر راودتها الطريق نحو آبار المعنى'. صحيح، لقد أهرقْتُ في الديوان حبراً عن ملامح من سيرتي الحزينة عبر ذاتٍ تعيش تجربة العبور في ترحالها بين الأمكنة الهاربة، بمقدار ما عمّقتُ فيها ملامح من شعريّتي الخاصّة.
بعد ستّ سنوات من ذلك التاريخ، فإنّ الذي تبقّى لي من ديواني الأوّل هو ذلك الوعد لا يزال يُنْبئ به ويتطلّبه منّي باستمرار. وعد السحاب. ليس السحاب حيث مكمن الماء والضوء إلّا الأمل من نقطة التماسّ تلك، بين ما كان وما سيكون، وهو ما يجعل المعنى في رؤيتي إلى الذات والعالم يتشكّلُ مُعانياً دبيب الأدخنة من كلّ مكان.
وعـــــد
ما بي أرى جُرْحي
أخفَّ إليّ منْ سَقْف الغُبارْ؟
أَهُشُّ، في ليْلٍ، على ظلًي وأنظرُ في السّماء
كأنّ مِنْ حجرٍ رُؤَى المَوْتى تَصيح،
أقولُ في نفسي: خفافا تعْبر الطّيْرُ الطّريقَ
إلى سحاب سدوم ناياتٍ، وتأثرُ بَعْد عيْنْ
واريْتُ مرآتي التُرابْ كأيً أَعْمى؛
في دمي تغْفو نساءُ الاستعارة
يفترين عليّ: كَمْ رؤْيا، صباحَ اللًيْلِ، لَـوْ وصل الغريبةَ وارفُ الأنقاضِ؛
لَوْ رَعَيا مياهاً في الدّخائل،
وَاْستحمّا مرّتيْنْ
مع الجيل بين قرنين:
لم يكن عُكوفي على الشعر، قارئاً وكاتباً، يتمّ خارج وعيي بعصري بقدر فهمي لمعطياته وأحداثه وهزّاته وزلازله في نهايات القرن العشرين، التي كانت تُقدّم، بالنسبة لي، علاماتٍ مضطربة ومحكيّات يائسة: أحداث 1984م و1990 الاجتماعية بالدار البيضاء وفاس، التي فجّرها واقع الفقر والاضطهاد بالمغرب. صمت المثقفين المطبق أو استقالتهم أو استخذاؤهم بعد "سنوات الرصاص". جنازة العاهل الحسن الثاني المهيبة التي أعقبها كشف حقائق مريعة. مآسي القضية الفلسطينية بعد أوسلو. الحرب على العراق وحصاره. المنايا المتقاربة لكلّ من عبدالله راجع وأحمد الجوماري وأحمد المجاطي وأحمد بركات، وانتحار كريم حوماري الفاجع. دويّ قصيدة النثر في المشرق والمغرب. منفى اللغة العربية. تراجع دور الأدب في المجتمع. صعود الأصوليّات من كلّ نوع. زحف العولمة في ظلّ انطلاق التكنولوجيات الجديدة التي بدّدت النزعة الإنْسيّة، وحطّمت أطراً في الفكر والثقافة، ممّا ترتّب عنه ظهور أجيالٍ أدبية وفنّية جديدة لها صيغ أخرى في التفكير والرؤية والإحساس، وإن كان كثيراً لم يسلم من مثالب التهافت والسرعة والتجهيل، ومن صرعات "قتل الأب". ولقد بات الكثير مقتنعاً، قبيل ساعة من رحيله، بجنازات نهاية القرن العشرين ومآتمها وزلازلها، عكس تفاؤل البداية والصورة الطليعية التي ارتبطت به. ولم تكن بداية الألفية الجديدة إلّا نتاجاً طبيعيّاً لمقدّمات قرن قيامي كالح، وإذا أوحت إلينا بشيء، فها هو مدبوغاً على ورقنا الذي نتنفّسه حزناً وإيلاماً. لذلك، لا يُخطئ القارئ أن يكتشف هذا المناخ من اليأس والاغتراب حيناً، ومن السوداوية والشعور بالعبث حيناً آخر، ذلك الذي يطبع شعر الجيل الذي أنتمي إليه، والمولود في بحر السبعينيّات المتلاطم مدّاً وجزراً، نثراً وشعراً.
في هذا المناخ، هناك الذّات فقط. الذّات المتشظّية، لكن المنفعلة والمركّبة التي تشي بهشاشتها، وتطفح بغيارات صوتها الحميم، وتنزع نحو المجهول، وقد ولّت ظهرها للمعضلات الكبرى، وعكفت بدل ذلك على ما يعجّ به اليومي والعابر والهامشيّ والخاصّ من تباريح ونقائض وتفاصيل وإيحاءات، مرتفعةً بانفعالاتها واستيهاماتها وعلاقاتها وحيواتها إلى مستوى أسطرتها، وبالتالي شخصنة متخيّلها الشعري. ونتيجةً لذلك، برزت رؤى شعرية جديدة في نصوص هذا الجيل، تعكس في مجملها إمّا وضع الاغتراب واليأس والحزن التي تتملّك الذات، أو استقالة الذات من الواقع ونفض اليد عن إلزاماته وحاجياته، أو الرغبة الطافحة بالحب والأمل في إعادة صياغة الحياة والتحرُّر من القيود، أو التوق لتحقيق التوحُّد مع المطلق. لكنّ قليلاً من أفراده من عبر إيقاع التحوّلات وفكّر في ذاتيّته خارج الخُطاطات المعروضة، فخرج ظافراً بقصيدته، وأكثريّتهم حاصرت نفسها في ضرب من التنميط عديم الموهبة والجهد الفني، فتشابهت تشابُهَ الرّمل.
لقد بدا للعيان أنّ القصيدة التي صِرْتُ أكتبها، ويكتبها بعضٌ من أبناء جيلي، قد أظهرت جماليّاتٍ كتابيّة جديدة، وعكست فهماً جديداً لآليّات تدبُّر الكيان الشعري، يمكن للمهتمّ أن يتتبّعه ويتقرّاه في دواوينهم التي شرعت في الظهور منذ أواخر التسعينيّات، ونُشرت على نفقتهم الخاصة بسبب غياب الدعم والعماء الذي ووجهوا به، أو في إطار سلسلة "الإصدار الأول" الذي أطلقته وزارة الثقافة بعد ردح من القهر.
وإذا كان العقد الأوّل من الألفية قد شهد حركة مطّردة، وغير مسبوقة، في النشر من الجنسين معاً، إلّا أنّه من الصعب أن نتحدّث عن "حركة شعريّة" على الأرض، لكن بِتْنا نَتبيّنها في الأفق.
ولادة تجربة تحلم بالعبور:
لا تَأْلو تجربتي الشعرية إلى اليوم جهداً للتعلّم والإصغاء إلى زمنها، كيما تبقى متيقّظة وحيّة. ولعلّ الروافد التي شكّلت تلك أقانيم تجربتي، فيما أرى، متنوّعة ومتجاذبة، منها ما يعود إلى التراث الشعري العربي، ومنها ما يمتح من اتّجاهات الشعر الحديث والمعاصر. وعلى العموم، أنا أنتمي إلى شجرة الشعرية العربية الأعرض التي تضرب بأطنابها في عمق التاريخ واللغة والثقافة، وما طفقت تجدّد آليات عملها الكتابي والتخييلي، وتأويلها الخصيب للذات والعالم. أنتمي إلى النصوص التي تحمي العمق، وتتطور داخل جماليات اللغة العربية. وهكذا، أزعم أن الصفحة التي أخط فيها شعري هي، سلفا، مسودّة بحبر أولئك الشعراء الذين أتقاسم معهم ميراثاً عظيماً من الحبّ والمسؤولية. وداخل هذا الانتماء الأعرض، أتعلّم كيف أنصت إلى ثقافتي المحلّية التي هي جزء أساسي ومختلف داخل الثقافة العربية الإسلامية. من ثقافتي المغربية، بجذورها الأمازيغية والإفريقية والأندلسية، أسترفد مُتخيّلاً مُصطخباً يَدلّني على التنوّع الذي يُلهمنا الحياة التي نتوجّه إليها، ويجعل الهويّة التي نتكلّمها أو نحلم بالعبور إليها دائمة التحوّل. من هنا، يهمّني التعبير عن روحيّة الشعر المغربي وروائحه وأمكنته ورموزه وهواجسه. ولا أفهم شاعراً مغربيّاً لا يعبّر عن ذلك، ويظلّ مغترباً في الأشباح بحثاً عن حداثةٍ مزعومة أو خلاصٍ كاذب. ومن الدالّ أن أذكر، هنا، أنّ أوّل قصيدة دشّنت بها ديواني"لماذا أشهدت عليّ وعد السحاب؟"، موسومة ب"مرآة أبودا وما فاض عنها في اللغة الأمازيغية"، ولم يكن هذا الديوان باكورتي الأولى، فقد سبقته بواكير أخرى كانت مسودّات ضمّت أخطائي الأولى، ووحيي الأول، ولغة عبوري الأولى، وقد مزجت أمشاجاً من الرومانسي والواقعي وأشكالاً من العمودي والرباعية والموشح والتفعيلة، لكنّها ضاعت منّي لكثرة تنقُّلي بين الأمكنة.
في ديواني الأوّل "لماذا أشهدت عليّ وعد السحاب؟"، والدواوين الثلاثة التالية: "ما يُشبه ناياً على آثارها" (2005)، و"ترياق" (2009)، و"ذاكرةٌ ليوم آخر" (2013)، أحاول قدر الإمكان أن أطوّر تجربتي، بدءاً من الغنائية التي أعمل عليها باستمرار بجذريْها العاطفي والرمزي، وانتهاءً برفْد المتخيّل الذي يدفع بالذّات إلى أقصاها في مخاطبة المطلق عبر وجوهٍ وحيواتٍ وعوالم متعدّدة، بهذا الشكل أو ذاك. فلا يعنيني في الأشكال التي اُكبّ عليها بقدر عنايتي بإيقاع الذات والعمل عليه داخل البناء النصّي الذي ترفده موسيقى هامسة من الإيقاع، ويسهم فيه تنويع التراكيب، مثلما عنايتي بالتصوير الشعري وإدارته في إطار من الحوار الخارجي الذي يستبطن الحالات الشعرية المختلفة، وهي تشفّ عن ذاتيّتي وشرطها الثقافي والوجودي.
لنقل هي تجربة تتنامى في عبورها الخاص، وفي انتباهها الخاص، مُنْحازةً أكثر إلى كتابة تشفُّ عن ذاتٍ تعاني عزلتها، وتواجه هشاشتها، فيما هي تطفح بالحب والغناء والأمل في إعادة صياغة الحياة والتحرُّر من القيود والأوهام. بهذا المعنى، لا أنسى أن أحتفظ بقدر من التفاؤل الذي لا يُعمي الرؤية، ويترك الوعد بلغة الحياة مستأْنَفاً على الدوام.
الكتابة بصيغة الذهاب-الإياب:
كان الشاعر أوّلاً، ثُمّ التحق به الناقد بعد دراستي الأكاديمية في الجامعة على يد أساتذةٍ أكفاء من جامعة ابن طفيل بالقنيطرة 1992، إلى جامعة محمد الخامس 1996م. أشعر أنّ هذا اللقاء الذي تمّ بينهما كان ضروريّاً، فبعد الموهبة وشطحاتها لا مندوحة من خبرة ووعي وتأمُّل هي متاع الناقد نفسه. لنقل إنّ هناك تجاوباً بين الشعر والنقد، هو تجاوب فعاليّتين تتحاوران في الذهاب-الإياب داخل معماري الكتابي، ولا تقعان على طرفي نقيض. فكل منهما يلبي حاجةً نفسيةً، علاوةً على ما ينهضان به من أعباء المعرفة والتأمل والبحث. وأحاول –بقدر ما أستطيع- أن أحتفظ بالتوازن الخلّاق بين الفعّاليتين معاً. كتابة القصيدة تحتاج -أوّلاً- إلى استغراق شبه كُلّي ينقطع إلى أسرارها وما يفعله دبيبها في الروح والوعي، لكنها لا تنفصل تماماً عن اشتراطات التي الكتابة تدبّر بؤر تشويشها وتخلّصها من زوائدها، كما لا تنفصل عن خصوصيّات الجنس الذي تنكتب في ضوئه. أما في لحظة الكتابة النقدية فأنا أذهب إلى النصوص وأقترب منها مصغياً إلى فرادتها وشعريّتها، بانفتاحي على تجربتي ومقروئيتي التي راكمتُها بجوار القصيدة، وعلى أدوات النظرية التي أنتقي منها ما يفيد عبوراتي إلى تلك النصوص ولا يثقل عليها بداعي المنهاجية. أنا، ناقداً، مسكونٌ بالشعر، وبمعرفة الشعر. وبداخلي ثمّة فرحٌ داخليٌّ، يُحرّكني للكتابة عن هذا الشاعر أو ذاك، وعن هذا الديوان أو ذاك. إنّ الإقامة هي ذلك الذهاب-الإياب الذي أذرعه في عمل الكتابة ومجهولها، وقد تكون على حوافّ الخطر.
إذا رجعنا إلى تاريخ النقد الحديث وجدنا أنّ أهمّ الكشوفات والإضاءات التي أفادت شعرنا العربي وقدّمته إلى جمهور القراء، تمّت على أيدي شعراء نقاد، من أمثال: أدونيس، يوسف الخال، صلاح عبد الصبور، علي جعفر العلاق، محمد بنيس، تمثيلاً لا حصراً. أهمّ نقاد الشعر ومنظّريه هم الشعراء أنفسهم، الذي يعرفون أنّ الكتابة تذهب نحو ما لا تعرفه، نحو ما ليس لها، أي نحو مُمْكنها الذي تتنصّت عليه النظريّة. بطبيعة الحال، هذا لا ينتقص من نقاد أكاديميّين متمرّسين ساهموا بقدر وافر في الرقيّ بالذائقة النقدية. لكن يبدو لي أن نقد الشعراء هو أكثر سلاسة وأكثر كشفاً، يعنى بإبداعيّة اللغة ومحسوسيّة الرؤية في التحليل. وإن كان يهمُّه هو الآخر المعرفة بالمنهج، لكنّه لا يصير مريض النظرية، غارقاً في شكليات البحث والنزوع السكولائي.
المعنى، الإيقاع، الشعر والنثر:
تولّد الاهتمام لديّ بالمنجز النقدي والبلاغي للشعرية العربية من دراستي الجامعية، بموازاة مع اهتمامي الشخصي بتجارب الشعر العربي الحديث التي كانت تنادي عليّ من أمكنة بعيدة . ظهرَتْ بهذا الخصوص ثلاثُ دراسات: “تحوُّلات المعنى في الشعر العربي” (الشارقة 2009)، و”نقد الإيقاع: في مفهوم الإيقاع وتعبيراته الجمالية وآليّات تلقِّيه عند العرب” (الرباط 2011)، “الشعر والنثر في التراث البلاغي والنقدي” (الرياض 2013). في الأولى، درستُ المعنى في الشعرية العربية قديمها وحديثها، مبرزاً كيف انتقل الاهتمام من تراتبية المعنى وأسبقيّته في شعريتي البيان والتخييل من خلال التشديد على المقصديّة ووضوح الدّلالة أو على المحاكاة والتأويل النفساني، إلى الاهتمام بدلاليّة الخطاب في سياق ما تمّ إبدالات معرفية وجمالية تأثّر بها بناء المعنى وآليّات اشتغاله في الشعر الحديث، وما ترتَّب على ذلك من أزمة تلقِّي المعنى الجديد. وفي الثانية، قادتني قراءتي للشعر العربي وشغفي بموسيقاه إلى لملمة كثير من القضايا التي تتّصل بالعروض والإيقاع في الشعر العربي ونظريّته، مُبْرزاً كيف تطوّر تأمُّل مفهوم الإيقاع في الدراسات ذات الصلة، وتطوّرت آليّات تلقّيه من طرف عروضيّين، وعلماء بالشِّعر، وبلاغيّين، وموسيقيّين، وتجويديّين، وفلاسفة، وقد كانت تعبيراتهم الجماليّة نابعة من تأمُّل إمكانات عمله في الشعر العربي بأشكاله المختلفة (الرجز، القصيدة، الموشّح والزجل) . ومثلما في تحوُّلات المعنى، كان انشغالنا النظريّ يصدر في منهج التحليل عن تصوُّرٍ ينظرُ إلى الإيقاع متلبّساً بتاريخيّته، حيث قوانين الإيقاع وآليّات عمله، داخل الشعر العربي، ليست واحدة، كما أنّ زمن بروز بعض أشكاله وظواهره يظلّ مُرْتبطاً بالتحوُّلات التي تُصيب هويّة القصيدة العربية بتنوُّع أنماط بنائها. وهكذا، فالمنهج الذي نعتمده ونراقبه هو منهج الشعرية عبر إستراتيجية الذّهاب-الإياب بين النصّ والنظرية.
أما الدراسة الثالثة فقد أظهرتْ أنَّ أهمّ المشكلات النظرية والسياسية للكتابة وتاريخيّتها يرتدُّ معظمها إلى هذا التقابل بين الشعر والنثر، ليس في تاريخنا الثقافي فحسب، بل حتى في تاريخ ثقافات ثانية، بما فيها الثقافة الأوربية. فالتقابل بين النَّثْر والشِّعْر يكشف عن نفسه في ثلاثة معالم : البيت الشّعري، الـ"صُّورة" والتَّخييل، بما هي معايير استعماليّة. الأوّل الذي يُعرِّف الشعر من خلال البيت والإيقاع من خلال الوزن يجعل النّثْر تالياً؛ ويُميّز الآخر الشعر من خلال الصُّورة، فيما يكون النثر معقولية وتَمْثيلاً ذِهنيّاً. وفي كلتا الحالتين، يكون الشِّعْر مُركَّزاً عليه: النّثر هو ما دون الإيقاع، وما دون الصورة. بينما النثر يكون مُركَّزاً عليه في مهيمنة التخييل فحسب، والشعر بخلافه، وذلك وفق المقولات الجارية. لكنّي في الكتاب الذي أشرتِ إليه كنتُ بمثل هذه الأسئلة: كيف تشكّلت ثنائيّة الشعر والنثر؟ هل كانت مقابلة أحدهما بالآخر تفيد في توضيح الحدود، وتجلو العلاقة بينهما؟ كيف خلط ربط الإيقاع بالوزن والبيت الشعري بين المنجز والمحتمل، وعقّد وضعية الكتابة؟ ما هو أثر المقدّس الذي خلفته البحوث الإعجازية حول المعجز القرآني في التباس الحدود بين أنماط الكتابة؟ كيف تدخّلت استراتيجيّات القراءة والتّأويل في توجيه الثنائية، بلاغيّة كانت أو إعجازية أو فلسفية ؟
لقد وجد أنّ آراء البلاغيّين والنقّاد تُشير إلى ما يختصُّ به الشعر، وما يختصُّ به النثر عموماً، إلّا أنَّ تفكيرهم لم يتعدَّ إلى الاهتمام بمسألة الاختلاف في النّوْع لا الاختلاف في الدرجة، وربّما هذا ما منعها من إدراك الفروق النوعيّة بين الشعر والنثر كنمطين كتابيّيْن، ولم تُحِطْ بنوع العناصر والبنى والعلاقات النصّية التي يقومُ عليها كلٌّ منهما. لكن دائماً ما كانت ثمّة حدود بين الشعر والنثر، وهي لا زالت إلى اليوم، وإن صارت بدرجة أخفّ وأقلّ حدّةً بالنظر إلى تحوُّل مفهوم الكتابة نفسه، وتبلبل نظريّة الأجناس برمّتها.
مع ذلك، أنا مُمارسٌ للشعر، وهو الأوّل والأَوْلى؛ لكن لا أدّعي أنّي مُنظِّر للشعر. التنظير للشعر يتطلّب خبرة كبيرة به وعملاً يتّجه بالنقد نحو إبستيمولوجيا الكتابة التي ترتبط، في تصوُّري، ببناء المفاهيم التي تكون نتاج تفاعل بين الممارسة ونظريّتها. لا زلت أعتبر نفسي دون ذلك، إلّا أنّ عملي على نقد الشعرية العربية وتأويل النصوص والتجارب الشعرية الجديدة مُهمّ في هذا الاتّجاه: من المعنى إلى الإيقاع، ومن الشعر إلى النثر.
ترجمة الشعر.. في معنى الضيافة والواجب:
لطالما فكّرْتُ، وأنا أقرأ الشّعر مُترجَماً أو بصدد ترجمته عن الفرنسية، في ما رآه الجاحظ، وهو يقول إنّ "الشعر لا يُستطاع أن يُترْجَم، ولا يجوزُ عليه النقل، ومتى حُوّل تقطَّع نظْمُه، وبَطُل وزْنُه، وذهبَ حسْنُه، وسقطَ موْضعُ التعجُّب، لا كالكلام المنثور". الشعر لا كالنثر. قد يجوز الأمر في النثر، الواضح والمعقول والعادي. أمّا في الشعر، الغامض والهشّ، فإنّه يصعب من وُجوهٍ كثيرة، حتّى يستحيل الأمر خيانةً، بله خسارة. لا يضيع المعنى فحسب، بل الأسلوب وإيقاع الكلمات وجرسها العابر للذّات وخطابها المفرد والخاص. هذا واقعٌ لسوء حظّ الشعر. لكن، أليس بالإمكان ترجمة الشعر؟ بلى. لا أنسى، هنا، رأياً ثانياً للشاعر الفرنسي بيير ليريس، وهو يرشدنا إلى أنّ "ترجمة الشعر أمْرٌ مستحيل، مثلما الامتناع عن ترجمته أمرٌ مستحيل". كثيرٌ من الثقافات الإنسانية الشفوية والمكتوبة، بما في ذلك الثقافة العربية ـ الإسلامية، التي يأخذ فيها الشعر وضعاً إعتباريّاً ولافتاً، وجدت في هجرة أدبها، من ضمن نتاجها الرمزي، إلى العالم ضرورةً لا ترفاً، ومجلبةً للاحترام والمجد، إذ هو يعكس وجهاً حيويّاً ومشرقاً من هويّة هذه الثقافة وتلك. وقد رأينا، عبر عهودٍ من حيويّة التاريخ، كيف كان تتفاعل الحضارات والشعوب وتتحاور، بقدرما تتناقله بينها من آدابٍ وفنون ومعارف، بل إنّ منها من تغيَّر وجهها بسبب الشعر مجسّداً في أغنية أو قماشة أو آنية قذفت بها الرياح إلى ما وراء البحر.
بالنسبة لي، لا أعتبر نفسي مترجماً، أنا قارئ للشعر "الآخر"ـ الفرنسي تحديداًـ، وفي نيّتي أن أتعلَّم من متخيّلات شعرية غريبة عنّي بما توافر لها من أسباب العجب والفرادة والاختلاف، لكن سرعان ما وجدتُ نفسي أرتكب مثل تلك الخيانة الممتحنة لمدى خيالي. في ترجماتي المقترحة لنصوصٍ من الشعر الفرنسي المعاصر، لاسيما نصوص هنري ميشونيك وأندري فيلتر وبرنار مازو وماري كلير بانكار، تبيّن لي أن لكلّ شاعر "عقدة إيقاعيّة"، وليس بمقدوري أن أعكسها إلّا على نحو تعويضيّ، إن ملأتها بذبذباتٍ من وجيبي الداخلي الذي يتجاوب مع تجاربهم المنادية عليّ، وأدخلتُها في علائق صوتيّة ودلاليّة جديدة تمنحها تأويلاً جديداً، وقيمةً مُضافة جديدة داخل لغتي التي أُبدع بها، وأحيا فيها . لكنّي، في كلّ يومٍ أكتشف ما معنى أن تصير الترجمة "محكّاً"، فلمّا نحن نترجم "فكأنّنا نلقى بين اللغتين تفاهماً هو من العمق والانسجام، بحيث تحلّان محلَّ المعنى وتتمكَّنان من جعل الفجوة بينهما منبعاً لمعنى جديد"، بتعبير موريس بلانشو.
في زمننا، صار لترجمة الشّعر معنى الواجب. شعريّات الأرض الباذخة والعريقة انفتحت على بعضها البعض، في حوارٍ خلّاق ومتوهِّج يعلِّم الكائن كيف يُشرف على كينونة لغة إنسانيّةٍ بلا حدود، بمنأى عن الابتذال والتسطيح. ولقد انفتحت الشعرية العربية الحديثة، عن طريق الترجمة، على بعض هذه الشعريات، الفرنسية والإنجليزية ثمّ الروسية والإسبانية والألمانية والإيطالية فيما بعد، التي كان لها دور حاسم ومهمّ في سيرورة تحديث الشعر العربي، حتّى صار شعراءٌ ذائعو الصيت يشكّلون فنناً مضيئاً من شجرة هذا الشعر وذاكرته ومتخيّله، من أمثال إليوت وإديث ستويل وسان جون بيرس وروني شار وعمر الخيام ونيرودا وناظم حكمت وطاغور وويتمان وبودلير وخيمينيث وييتس وأوكتافيو باث وبورخيس وآرتو وإزرا باوند ولوركا وألن بو وريلكه وهولدرلين وإيلوار وبريتون وميشو وبيسوا وسواهم، وصولاً إلى نماذج من الشعر الصيني وشعر الهايكو الياباني حديثي الاكتشاف. ولهذا، ليس في الإمكان أن نقرأ مسارات الحداثة الشعرية العربية بمعزل عن دور الترجمات الشعرية المتنوعة التي تمّت بمستويات متباينة. وإذا عدنا الى بدايات القصيدة الحديثة وجدنا أن الترجمات تحضر بنفس قوة الآثار المنتجة. تحضر هذه الأعمال: أنشودة المطر، وأباريق مهشمة، وأقول لكم، وأغاني مهيار الدمشقي، ولن، وحزن في ضوء القمر، إلى جانب الأرض اليباب، وأربعاء الرماد، والرجال الجوف، وأزهار الشر، وعيون إلزا، ومنارات، وأوراق العشب، وأغان غجرية، وراعي القطيع.
لكم من شاعر عربي حديث، من جيلٍ إلى آخر، قد استضاف شاعراً أجنبيّاً، وارتبط اسمه به، وتحاور معه. السياب وستويل، عبدالصبور وإليوت، أدونيس وبيرس، سعدي وريتسوس، يوسف الخال وباوند، أنسي الحاج وآرتو، فؤاد رفقة وهولدرلين، المهدي أخريف وبيسوا، رفعت سلام وكفافيس، محمد بنيس ونويل، وإدريس الملياني ويفتوشينكو وقد يفرد شاعر أو ذاك جناحه على جملة شعراء عرب محدثين ومعاصرين، مثل إليوت ولوركا وبريتون وبيسوا. غير أنّ الأثر المتبادل، عن طريق الترجمة، بين الشعر العربي والشعر الأجنبي بلغاته المتباينة، لم يكن متساوياً وواقعاً بالقدر نفسه. نماذج محدودة من الشعر العربي القديم، بما فيه الأندلسي، من أحدثت أثرها في الشعر الآخر، لكن من الصعب أن نثبت إلى أيّ حدٍّ أثّر هذا الشاعر من شعراء العربية المحدثين في مجرى الشعر العالمي، وإن كنّا لا نغفل الهالة التي صارت لبعضهم تحت هذا التأثير أو ذاك، مثلما هالة محمود درويش أو أدونيس. هل يصحّ لنا أن نؤكِّد أنّنا أخذنا أكثر مما أعطينا بكثير، وتأثّرْنا أكثر مما أثّرنا؟!
في كلّ الأحوال، لقد أفَدْنا من ترجمة الشعر التي تمّت على أيدي الشعراء أنفسهم، هؤلاء النادرين الذين لا يُضاهيهم أحد، والذين يأخذون على عاتقهم تحديد معنى الأدب، والذين يعلمون قبل غيرهم أنّ ثمة نواة في القصيدة يجب الانتباه لها ومعاملتها بكثير من "الاحترام والتبجيل"، أثناء ترجمتها أو نقلها إلى لغتهم الأمّ. فعلى المترجم أن يكون عارفاً بلغة الشاعر الذي يترجمه، وإيقاعها، وأسلوب تشخيصها للذات الكاتبة والعالم الحسي والعقلي. ويجوز له أن يخرج عن الأصل بمقادير، مبدعاً فيه، ومهتدياً إلى ذلك بحدسه وإصغائه شديدي الإرهاف. فمن سوى الشاعر المترجم، إذن، يُدرك أنَّه بصدد فعلٍ كتابيٍّ لا يقلُّ إبداعيّةً، ويقرّ في أصالته ومسؤوليّته أن يستضيف الشعر "الآخر" بيديه الأمينتين المرتجفتين، حتى لا يطير عنه خياله ويغيض ماؤه، فتأتي الترجمة بأقلّ خسارة، بل تبزُّ أصلها. يجب، بهذا المعنى، أن يؤمِّن الاختلاف حتؤ يبعث في لغته، بما يحمل إليها من تحوُّلاتٍ عنيفة أو رقيقة، حضوراً لما هو مختلفٌ، أصلاً، في الأصل. هذا النوع من الترجمة الإبداعية صارت له قيمته في الفترة ما بعد الاستعمارية، بعد عهود من سوء الفهم العظيم التي أشاعها الاستشراق.
لماذا الشِّعر؟
في ضوء محبّتي للشعر وانشغالي به، أو تحت تأثيره وإغوائه، كُنْتُ دائماً أَطْرح على نفسي سؤال الجدوى من الشّعر، وهو السؤال نفسه الذي أجده يتراقص على أجناب قِصّتي مع الشعر:
لماذا الشِّعر؟
لكنّ سؤالي لا يمكن أن أفصله ألبتّة عن سؤال أصبح مع الوقت إشكاليّةً تُشيعها تداوليّةً مُعمّمة بشكل لا يُطاق، إذ بدا يُطْرح اليوم بحدّةٍ واطّرادٍ شديدَيْن في ثقافتنا المعاصرة، لسببَيْن:
الأوّل، لكون الشّعر يشغل حيّزاً مهمّاً من شواهد إرثنا الثقافي والجمالي الضارب بأطنابه في أعماق التاريخ والحضارة، والهاجع في اللاوعي الجمعي،
والثّاني، جَرّاء الخوْف من التّقنيّة الّتي تسبّب للشعر مَغْصاً عسيراً، وللشّعراء تيهاً في المجهول، وللذّائقة اغتراباً متصاعداً. بالكاد، داخل الثّرثرة الكونيّة الّتي تروّجها وسائط الميديا المختلفة والضاجّة، يصل صوت الشّعر الأجشّ والمبحوح، حتّى اعتقد الكثير، بمن فيهم الشّعراء أنفسهم، أنّ زمن الشّعر ولّى، وأنّ الوظائف التّقليديّة الّتي ارتبطت به وتقول بخلاص الكائن صارت مضحكة، وأنّ قوله بات ضرباً من العبث، وأنّ جماله يائسٌ لا طائل منه. لكن يبدو لي، اليوم، أنّ المشكل الحقيقي للشّعر هو مشكل تاريخيّته الّذي لا يمكن أن يُطرح بهذه الصيغة من الاختزال والتّبسيط، فليست تاريخيّة الشّعر اختزال الشّعر إلى تاريخه، بل الحركة الّتي تحمل على أن يكون نفسه الرّاهنية الدّائمة للُغته الخاصّة الّتي تعِدُ بالمعنى، وتستأنفه. من هُنا، يرتبط السّؤال بسؤال القيمة والأثر، أي بالمستقبل الّذي يتمّ فيه فهمنا للشّعر كخطابٍ نوعيٍّ تغدو فيه القصيدة والذّات وفعّالية المعنى عناصر متحوِّلة، باستمرار.
إنّ الوضعيّة الّتي يمرّ منها/ بها الشّعر راهناً تحتاج إلى شيء من الرويّة، وإلى إعادة وضع سؤال الجدوى في سياق التحوّلات المتسارعة، ومشاغل الكائن الجديدة بدل أن نسأل هل تراجع دور الشّعر في حياتنا، يجب أن نعرف هل هناك شعرٌ أم لا؟ كما يجب أن نعرف هل أدرك الشّعراء سياسات القصيدة في زمنها، بمعنى هل انتبهت إلى الحاجات الرّوحيّة والجماليّة للإنسان المعاصر؟ وهل ذهبوا هُمْ أنفسهم إلى أمكنة أخرى لبحث الشّعر ومقاربته؟ نطرح هذه الأسئلة من ضمن أخرى متشعّبة لنؤكّد ضرورة الشّعر، وكتابتَه الّتي تتوجّه إلى المستقبل وتُصغي إليه، وأهمّية أن يستبدل الشعراء مفاهيم وآليّات عمل الشّعر وترهينه. ثمّة مستقبل للشّعر يصير بين شرائط ثقافيّة جديدة وعابرة للذّوات والخطابات والأزمنة، بما في ذلك غير الشّعرية الّتي تُشيعها وسائط العولمة. يفرض علينا الفضاء الاتصاليّ المعولم الوعي بلحظتنا الرّاهنة، من حيث التعاطي مع معادلات وسائطية ومفاهيمية جديدة كالفضاءات الافتراضيّة، والنشر الإلكتروني، والأقراص الممغنطة، الّتي يقابلها اهتمامُ الذّائقة الجديدة بالنصوص الإبداعية المتعالقة ومن ضمنها النصّ الشعري ـ
في الظّروف الراهنة، من عديم الجدوى أن يبحث الشّعر عن دوْرٍ جماهيريّ، أو بالأحرى يُبْحث له عن مثل هذا الدّور، ولا وهم التّمثيل والمحاكاة، ولا عن خطاباتٍ تعزّز الإجماع الكاذب.
إنّ الّذين يرْبطون الشّعر بحالة الطمأنينة، وببلوغ الخلاص إنّما يتحاملون على الشّعر، ويُكرّسون فَهْم العامّة له كشيْء ساذج وعديم الجدوى. قُـوّة الشّعر في هشاشته التي لا تُزهرُ إلاّ في العتمة، وترقص على حوافّ الكارثة وتنبت في الشّقوق، وتدبّ بين تصدّعات الرّوح. إنّه لا أقلّ من هذا السّفر العابر في الجوهريّ، وفي الشعائر الهامسة، وفي طقوس الحبّ والجمال والغناء ولحظات التأمّل والإصغاء وسخاء الطّبيعة، وفي تنْبيه النّاس إلى عدم الانتقاص من الشعريّة المتناثرة في الحياة أنّى كانت، وفي حفظه لغة الحلم والمجاز والعمق الّتي تنعش في الإنسان قوّة الذّاكرة ورهافة الإصغاء وسماحة التّأويل، وفي بثّه المعاني الوجودية الأساسيّة ـ
هو ذا مستقبل الشّعر الّذي تُراقبه سياسات القصيدة. نقصد بسياسات القصيدة معنى الاستراتيجيّة الّتي تترك القيمة والأثر في حالة اشتغالٍ وانْدفاعٍ وتيقُّظ، وهي قويّة الإصغاء لما حولها، ومتحوّلة في داخلها. أمّا إيقاعها، إيقاع ذاتِها فإنّه يهجع في لاوعيها حيث يحفُز الشعراء، ويرعى اليائسين منهم، متوتّراً بين القول بـ"فضل قول الشاعر وصدعه بالحكمة فيما يقوله"، والاعتقاد بـ"أن الشّعر نقص وسفاهة". كما أخبرنا بذلك حازم القرطاجني في زمنٍ من الشّعر سحيق. ولنا أن نُشير، وسط الضجيج حتّى باسم الشعر، إلى أنّ هناك نماذجَ قوية ولافتة داخل الشعريّة العربيّة المعاصرة تصنع عبورها الخاصّ، وتقدِّم للمستقبل شهادات حياةٍ، وعلامات عافيةٍ وصحّةٍ روحيّةٍ تليق بالجوهريّ في الإنسان وعداه، حتى وإنْ طغى على الرّاهن سمات العزلة واليأس والخراب. إذا كان الأمر يتعلّق، هنا، بالقصيدة، بسياسات القصيدة، فلأنّ ثمّة ما يُظهر أنّ المغامرة الشعريّة والمغامرة الذّاتية متداخلتان تقتسمان التّاريخ نفسه، والعمل نفسه. ويأخذ الشعريّ في سياسات القصيدة صفة غير المكتمل نظريّاً، لأنّ الأخيرة تتضامن والخطاب في أن تظلّ القصيدة تطفح بالأدلّة دائماً. بهذا المعنى، تعرض علاقات القصيدة، بطريقتها المميّزة، الرّهان الابستيمولوجي للشّعر كـ"عمل فنّي مفتوح" على المجهول. وعليه، فليس الرّهان شعريّاً فحسب، بل أيضاً سياسيّ، من معنى إلى معنى. فافْهَمْ !
ما يُعزّز اقتناعي بقيمة الشعر وضرورته في عالمٍ صار يقلّ فيه ضوء الشعر، وتقلّ معه فرص الحياة الجميلة والمحلوم بها على حوافّ عالم يُغرقها في ماديّته الشرهة، أنّي هنا الآن أستعيد قِصّتي مع الشعر. وبالمناسبة نفسها، أريد أن أقول للقارئ الكريم إنّ ثمّة ما يدعونا للكشف والخلق والحوار وتبادل حرّ للأفكار والأحلام عن طريق الكلم الشعري، بقدرما ما يدعونا إلى التأمُّل في مكامن قوّة اللغة وإلى الإصغاء لتفتُّح الملكات الإبداعية لكلّ الذوات وهي تبتهج وتتوهّج في الشعر وبه. من ذات إلى ذات، من برعم إلى شجرة، نُصْغي إلى حياتنا المغدورة في الشعر، إلى هؤلاء المُحبّين الصاعدين في معارج الحلم والخيال، والمتنزّهين في غابة اللغة متنزّهين عن سفاسف الكلام، ومؤمنين بجدوى الشعر وضرورته.

التعديل الأخير تم: 01/04/2018