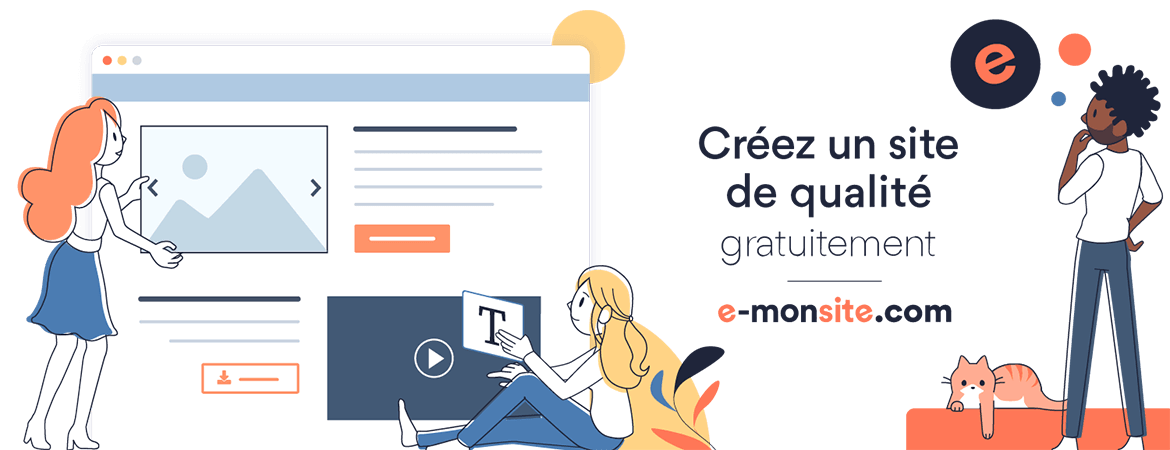هويّات الشعر المغربي
هويّات الشعر المغربي
«هويـات» الشعر المغربي: من صراع المركز والأطراف إلى مضايق التجربة
عبد اللطيف الوراري
فرضت كتب تاريخ الأدب العربي، بما فيها الحديثة، مركزاً وهوامش؛ ففي الوقت الذي سُلط فيه الضوء على حركة الآداب في العراق وبلاد الشام ومصر، باعتبارها تمثل المركز والأثر، لم تلق هذه الكتب بالاً بواقع الآداب في دول الخليج العربي واليمن والسودان والبلاد المغاربية، باعتبار أنها تمثل الهامش والصدى.
وإذا كان لدينا اليوم تراثٌ من عصر النهضة يتحدث عن جلائل الأعمال التي اضطلع بها الرعيل الأول من روادها في سبيل نهضة الأمة والعودة بها إلى روح العصر، إلا أن أكثرنا لا يعرف ـ تمثيلاً لا حصراً- ما أسداه أهل المغرب من فضل أيامئذٍ. وبسبب هذه الهامشية الجغرافية، وقبل ذلك لعنة الصاحب بن عباد التي ظلت تتردد عبر العصور وتقدم نتاج المغاربة الأدبي مثل «بضاعتنا رُدت إلينا»، ثُم حجاب العبقرية الأندلسية بآثارها الباذخة، فقد تكرست لدى كثير من المشارقة صورةَ أدبٍ مغربي هامشي ومجهول وغير متضح الهوية في أذهانهم.
لقد كانت كتب التاريخ الأدبي لا تدخل، عن جهْلٍ ونرجسية، في حسابها ما كان يكتبه المغاربة من شعر، معتقدة بأنه نسخة لأثرٍ مشرقي أو صدىً بعيد عنه، وهو ما لم يُقيض لها أن تتعرف على شخصيتهم الشعرية الخالصة، وأشواقهم الخاصة، ممهورةً بسؤال المغرب ومكانه الحضاري والثقافي المتنوع. وبالتالي، لم يٌتح للدرس النقدي الحديث أن يتداول إنتاج المغاربة الشعري، إلا بدايةً من المرافعة التاريخية للعلامة عبد الله كنون، التي أثارها في الثلاثينيات من القرن الفائت، وهو يصدع بـ«النبوغ المغربي» في كتابٍ يحمل العنوان نفسه.
وإذن، لقرون طويلة لا تعدم روح الكد ومحاولة إثبات الذات، لم يتوانَ شعراء المغرب عن الإبداع في سبل الفكر والأدب، حتى أمكن للشعر المغربي الحديث أن يُسْمع صوته، ويفرض حضوره بما وسعه الإمكان، فلم يعد النبوغ مُقيماً في تفاصيل التاريخ وشوارده، بل لافتاً وجالباً للإعجاب والمكْرُمة، منذ بدايات القرن العشرين على الأقل.
تاريخانية
انتهى الشعر في الربع الأخير من القرن التاسع عشر إلى حالة جمود؛ إذ صار موضوعه مرتبطاً في الأغلب بموضوعات العلوم والمعارف الأخرى، حتى تحول إلى مجرد نظمٍ به تُؤدى العلوم الفقهية واللغوية، ووسيلة لحفظ الشواهد في معرض علم النحو والبلاغة ورواية المثل السائر، بعد أن صارت «معظم علوم الأدب آلةً لفقه»، بل إنه تحول إلى مجرد مطية يركبها الناس للوصول إلى تولي بعض المناصب القضائية والإدارية. وكان شعر المناسبات الدينية والرسمية هو السائد مع ما يغلب عليه من تقليد وإسفاف. إلا أنه بدايةً من القرن العشرين، وتحت تأثير الحركة السلفية، أقبل الشعراء المغاربة على النظم في موضوعات تهم الدعوة إلى الإصلاح وتحرير الفكر؛ ثُم سرعان ما ظهر ثلة من الشعراء أُطلق عليهم شعراء الشباب الذين تأثروا بالمدرسة الإحيائية في الشعر، عبر ما كان يصلهم، من المشرق العربي، من أعمال شعرائها، ومن كتابات نقدية مصاحبة لطه حسين والرافعي والزيات والعقاد.
لقد خلق شعراء من أمثال القري، وعلال الفاسي، ومحمد المختار السوسي، ومحمد بن إبراهيم الملقب بشاعر الحمراء، وعبد المالك البلغيثي وسواهم، واقعاً جديداً كان إيذاناً بميلاد شعر النهضة في المغرب، وهو شعر يلتقي في صيغته بصيغة المدرسة الإحيائية. ولم يكن هذا الواقع يخلو من صراع بين المجددين والمقلدين، كان يرجح إلى كفة أنصار التجديد بحكم نشاطهم النقدي ونجاعة تصوراتهم في ضوء المفاهيم الجديدة التي آمنوا بها وشرعوا في نشرها وترسيخها، مؤكدين على أهمية رسالة الشعر ورفضهم التقاليد الشعرية المتكلسة، وذلك ما يظهر جلياً من نقود محمد بن العباس القباج، وعبد الله كنون، وعبد الله إبراهيم، وعبد السلام العلوي، وأحمد زياد وعبد العلي الوزاني.
وبعد أن تم التعرف على التيارات الذاتية المجددة، من قبيل أبولو والديوان والرابطة القلمية، ولد جيلٌ جديدٌ من الشعراء سرعان ما عمل على خلق حركة شعرية جديدة في موضوعاتها وأساليبها الفنية، وكان من أهم أفراده: عبد القادر حسن، وعبد الكريم بن ثابت، ومصطفى المعداوي، وعبد المجيد بنجلون، وعلال بن الهاشمي الفيلالي، والمدني الحمراوي ومحمد الحلوي، على اختلاف مستويات حضورهم ودرجة اقترابهم من المذهب الرومانسي أو الواقعي، وإن أجمعـــوا على التخلص من تقاليد القدماء ومحاكاتــــهم، وضـــرورة الــــتزام الصدق في التجربة والتصوير الفني: مــن الذات إلى الواقع. فكان مفهـــوم هؤلاء الشعراء للشعر ووعيهم بوظيفته يتطور تحت تأثير التصورات والرؤى المتباينة التي عرفها المغرب، منذ بداية القرن العشرين إلى بداية الســـتينيات من القرن نفسه، متوتراً بيـــن هاجـــس القطيعة وواجب الاستمرارية، كما يرى الناقد أحمد الطريسي أعراب.
بيد أن الصراع على ميدان الفكر الشعري كان دائماً يتجدد بتأثير من تقلبات المجتمع وأحوال السياسة، مثلما الصراع هذه المرة بين تيار التجربة الذاتية وتيار الالتزام. وإن كان المشرق العربي لا يزال يشكل رافداً لا غنى عنه، إلا أننا وجدنا بعضهم، من شعراء ونقاد، متأثراً بالرافد الأوروبي، والفرنسي تحديداً، فيذكر نماذجه، ويعقد المقارنات والموازنات بين الأدب العربي والأدب الأجنبي، وهو ما أغنى النقاش النقدي، وساعد الشعراء على تلمس سُبلٍ جديدة في الإبداع الشعري.
بعد استقلال المغرب، وابتداءً من ستينيات القرن العشرين، توجهت القصيدة المغربية بضفافها خارج التيارين المحافظ والرومانسي، اللذين كان يتلقفهما جمهور الشعر، متأثرة بحركة الشعر الحر التي انطلقت من أرض العراق مع الثالوث الريادي: بدر شاكر السياب، نازك الملائكة وعبد الوهاب البياتي، وذاعت في أكثر البلاد العربية، بفضل المجلات الأدبية والمجاميع الشعرية التي كانت تنتظم في الصدور. كان معظم ممثلي هذه القصيدة من الشباب المغربي الذي نال حظاً من الثقافة والتعليم الجامعي، بما فيه الذي تلقنه حتى من جامعات بغداد ودمشق والقاهرة، وهو ما كان يعني صلتهم المباشرة بمناخ تلك الحركة وزخمها العاطفي والفكري، من أمثال أحمد المجاطي، ومحمد السرغيني، ومحمد الخمار الكنوني، ومحمد الميموني، وعبد الكريم الطبال، وأحمد الجوماري وعبد الرفيع جواهري. وإذا كان أكثر هؤلاء قد كتب في أول عهده القصيدة العمودية مترسماً خطى سالفيهم، أو زاوج بينها وبين قصيدة التفعيلة، إلا أنه سرعان ما اختار أسلوب القصيدة الحرة، لعقودٍ تالية. وبناءً عليه، لا نذهب مع آخرين في رأيهم بأنه كانت هناك قطيعة بين فترتي تحديث الشعر المغربي، أي ما قبل الاستقلال وما بعده، بل هي بالأحرى تُجسد موجاتٍ من زخم التجديد والرغبة في مسايرته تبعاً لرؤى الشعراء وحساسيات ذواتهم وعصرهم الذي كانوا يعبرونه.
في الوقت الذي كانت تحصد فيه قصيدة الشعر الحر النجاح وتتطور بشكل متنامٍ على يد شعراء ملكوا الموهبة والخبرة بأدوات الشعر وعاركوا مضايقه، بقدر ما كانت تُوسع دائرة تلقيها تباعاً، كانت قصيدة الشعر العمودي تفقد تدريجياً حلبة القول الشعري للأولى، وتنحدر إلى طريق مسدود، بعدما غلبت عليها النزعة «المناسباتية» الفجة التي جلبت إليها أدعياء الشعر وناظميه بلا طائل، فبدت خلواً من التجويد الفني وصدق التعبير وحرارته.
عشرات الشعراء النظامين الذين تهافتوا على القصيدة العمودية وتصنعوها في مناسبات آنية، لم يعد يذكرهم أحدٌ، لكن صنيعهم حُسِم لصالح الشعراء المحدثين الذين بادروا إلى التجديد من الأول، بل وجدنا بعض الشعراء المشهود لهم بامتلاك الباع والناصية، قد ضعف إنتاجهم وغلبت عليه كلفة التصنع بسبب تلك النزعة، بمن فيهم إدريس الجاي نفسه.
وابتداءً من السبعينيات، ظهر جيل من الشعراء لم تُغْرِهم حبائل السلطة، بل قدموا من تجارب جديدة تولدت عن وعي فكري وأيديولوجي أكثر منه آنيا وعابرا. من أولئك من بقي منتصراً لنهجه التحرري في الالتزام بقضايا المجتمع المغربي الذين كان يمر بفترة عصيبة بعد اشتداد سنوات الرصاص، بمن فيهم محمد الوديع الأسفي محمد الحبيب الفرقاني. وفي المقابل، كان آخرون من أمثال: إدريس الملياني، ومحمد الشيخي، وعبد الله راجع، ومحمد الأشعري، ومحمد بنطلحة، وأحمد بنميمون، وعلال الحجام، وأحمد بلحاج آية وأرهام، وعبد الرحمن بوعلي، ورشيد المومني والمهدي أخريف، لم يُنْسِهم عُرام الأيديولوجيا، أن يواصلوا مشروع تحديث شكل القصيدة التفعيلية ولغتها، والانفتاح على المدونة الشعرية الحداثية؛ بل سعى بعضهم إلى مفهوم جديد للكتابة الشعرية عبر مشاريع «القصيدة الكاليغرافية» التي تنبني على التنوع السيميائي للخط، وتبئير علامات الترقيم وتنويع الأشكال البصرية، مثلما في نصوص محمد بنيس، وبنسالم حميش وأحمد بلبداوي.
ومن شعراء هذا الجيل من أخلص في وعيه الشعري، تحت الدعوة إلى أدب إسلامي، لتيارٍ بدا نابعاً بطبيعته من نزوعات الفكر الإيماني والصوفي، إذ يهتم بهموم الأمة ويستسلهم تراثها الإسلامي المضيء للجواب على أسئلة جمالية وفكرية بدت لهم مؤرقة وصادمة. وكان أغلب شعراء هذه التجربة ينحدرون من مدينة وجدة شرق المغرب، وأهمهم: حسن الأمراني، ومحمد بنعمارة، وفريد الأنصاري، ومحمد المنتصر الريسوني ومحمد علي الرباوي. ولعل من أهم خصائص قصائدهم، عدا التزامها نظام الشطرين أو المزاوجة بينه وبين نظام التفعيلة، أنها تستند إلى تصورٍ قيمي وأخلاقي شامل ينبع من ثقافة إسلامية، واعية ومتسامحة ومعتدلة ومتوازنة بين ما هو ذاتي وجماعي، وما هو دنيوي وأخروي. كما تتميز بسماتٍ فنية وجمالية تعتمد المشابهة والترميز والإيحاء بدون أن تسف إلى التهويم والضبابية والغموض، وتحتشد بأسماء الأعلام والأماكن والأقنعة والرموز العربية والإسلامية.
جماليات جديدة
في بحر الثمانينيات، بدا الشعر المغربي يتململ عن مكانه، ويولي وجهه شطر المغامرة. فأغلب شعراء هذا العقد كان له اطلاع على الشعر العالمي بلغاته الأصلية (الفرنسية، الإسبانية والإنكليزية)، وترعرع في ظل خيبات الاستقلال السياسي، يواجه العالم بـ«عراء أيديولوجي» ولا يحس بفداحة ما حوله، متحرراً من قيود والتزامات المرحلة السابقة. فوجد نفسه أمام اختيارين كتابيين: اختيار أفقي يتمثل في النزوع إلى اليومي والبسيط الذي يرتوي من معين المعرفة والتجربة، واختيار عمودي يرتقي بالقصيدة إلى ملكوت الرؤيا والرمز والتصوف. وكلاهما تنفس في فضاء قصيدة النثر، حيث إيقاع الذات، والاحتفاء باليومي، والاعتناء بالبناء السردي والشذري، في حِل من كل أيديولوجيا وشِعارية. ومن جملة هؤلاء، نذكر: حسن نجمي، وأحمد بركات، وإدريس عيسى، ومبارك وساط، وصلاح بوسريف، ومحمد بودويك، ووفاء العمراني، ومحمد الصابر، ومحمد بوجبيري، ومحمد عرش، ومحمد عزيز الحصيني، وعبد السلام الموساوي، وثريا ماجدولين، ونجيب خداري، ومحمد شاكر، وعزيز الحاكم، وعبد القادر وساط والزهرة المنصوري.
وما إن دلفنا إلى التسعينيات حتى تم تعزيز الخيار الثمانيني الذي يعطي الأسبقية للبناء على المعنى، وللجمالية على الشعارية؛ بل وجدنا الشعراء من أجيال سابقة تساهم في إثرائه باعتباره «خريطة طريق» للشعر المغربي ومستقبله، جنباً إلى جنب مع الشعراء الجدد الذي انفرطوا عن كل عقد، وزادوا لكثرتهم وتنوع أساليبهم في الكتابة وتدبر إوالياتها عن أيما حد، وهو ما كان إيذاناً بميلاد حساسية/ حساسيات جديدة بما تحفل به من تعدد مثمر وحياة خصيبة وواعدة، وما تكشف عنه من غنى المتن الشعري كماً ونوعاً، وتنوع منتجيه من كل أعمار الكتابة عبر رؤاها الحسية والوجودية والميتافيزيقية. وإذا كان لي أن أحددها بشيء، فيمكن أن أشير إلى الملمحين الرئيسيين:
– الانهمام بالذات في صوتها الخافت والحميم، وهي تواجه بهشاشتها وتصدعها الأشياء والعالم واختلاطات الحياة اليومية، بدلاً من معضلات المجتمع وهواجسه الحرى. وقد ترتب على ذلك تذويت الملفوظ الشعري وشخصنة الموضوعات والصور والمواقف من الذات والكتابة والوجود.
– بروز رؤى شعرية جديدة تعكس في مجملها، إما وضع الاغتراب واليأس والحزن الذي يتملك الذات، أو استقالة الذات من الواقع ونفض اليد عن إلزاماته وحاجياته، أو الرغبة الطافحة بالحب والأمل في إعادة صياغة الحياة والتحرر من القيود، أو التوق لتحقيق التوحد مع المطلق: (رؤية غنائية، نهلستية، سيريالية، إشراقية).
وقد بدت لنا الجماليات الجديدة التي يبدعها الشعر المغربي، منذ الثمانينيات على الأقل، جديرةً بالتأمل، لأنها قطعت مع ما سبقها في مناحٍ ذات اعتبار، وكرست وعياً جديدًا بالمسألة الشعرية برُمتها، بعد أن رفعت عنها السياسي والأيديولوجي، ويممت بوجهها شطر المغامرة، حتى إن ما كان مُتخفياً ومأمولاً أصبح أكثر حضوراً في تجربة الراهن.
غير أن النقد لم يَخُضْ فيها بعد، باستثناءات قليلة من ضمن ما يقترحه حاليًا نقادٌ نشيطون من أمثال: بنعيسى بوحمالة، ورشيد يحياوي، وصلاح بوسريف، وعبد السلام المساوي، وأحمد هاشم الريسوني وغيرهم. فإذا كانت تجارب شعرنا السابقة قد أُثيرت حولها نقاشات، واحْتُفي بها من قبل الدارسين بنسبٍ معقولة، مثلما كانت أصواتها مكرسة وذات رمزية بحكم ارتباطها بمشاريع ومؤسسات كانت تعتبر الموضوع الشعري، الرسالي تحديداً، امتداداً لخطابها، فإن تجربتنا الشعرية الراهنة تتكلم اليُتْم، وتُواجه العماء، مثلما أن كثيراً من أصواتها لم تُسمع، أو لا تُسمع إلا بالكاد. من هنا، يُجهل لحد الآن مما فيه اعتبار داخل الراهن الشعري.
إن راهن الشعر المغربي ينتظر من كافة المعنيين، شعراء ونقادا وقراء، صياغة أجوبة لأسئلة من بينها مثلاً: أيهما أولى، الكتابي أم الإنشادي في مجتمع ذي أغلبية أمية؟ أي زخم يمكن أن تضفيه المعرفة الفلسفية على الممارستين الشعرية والنقدية في المغرب؟ وأي موقع محتمل، في خريطتنا الشعرية، لشعراء قادمين إلى الشعر من معارف ومصادر وحساسيات وهوامش نصية لافتة؟ أي متخيل يمكن أن يرخيه مصطلح الكتابة الشعرية النسائية؟ بل أي متخيل شعري وطني يجب أن نهندسه بصدد شعراء مغاربة يكتبون بلهجاتهم المحلية (الأمازيغية، الحسانية والعامية)، أو بلُغات الدول التي تُضيفهم في المهاجر في أوروبا وكندا وسواهما؟
هذه الأسئلة هي إشكالية واستراتيجية في آن؛ لهذا، يجب أن تكون في صلب الانشـغال التنظيري والنقدي الذي ينبغي أن يهم مجالنا الثقافي والأدبي، بما فيه الشعري.
فاستئناف التفكير في أهم القضايا التي يقترحها الشعر المغربي راهنًا، والإصغاء إلى هسيس الذوات المبدعة، لهو مما يحفزنا على اعتناق التواريخ الموغلة في رحم النصوص؛ لأنه – بتعبير الناقد بنعيسى بوحمالة- «ليس بمقدور لا المنظور الأيديولوجي، بمسبقاته المتصلبة، ولا المنظور النصي، بعمائه التكنوقراطي، الولوج إلى مضمر القصيدة الشعرية، وإلى مكمن تجوهرها الفذ». فما يُنادينا من القصيدة سوى حيويتها الدائمة. الحيوية فقط، عبر تعدد هوياتها من ذات إلى ذات.