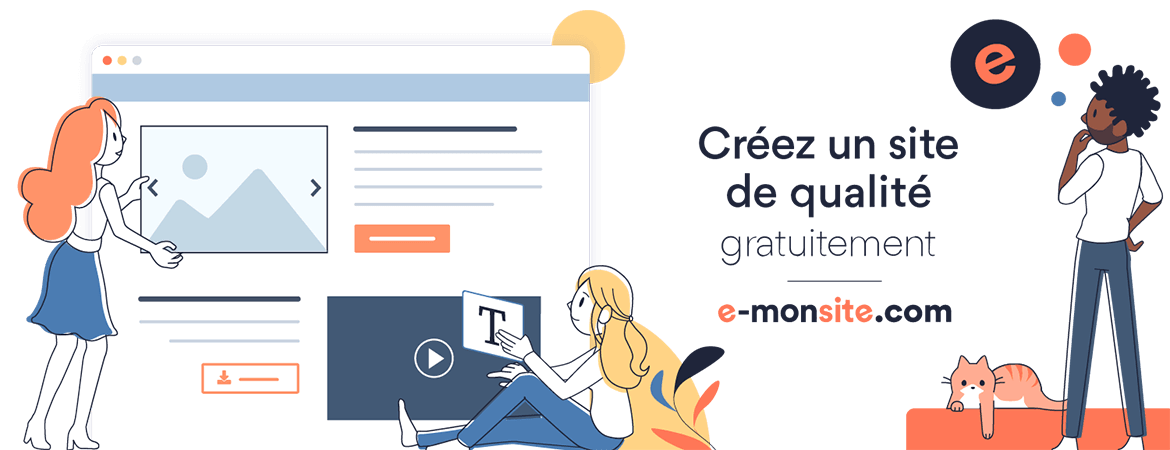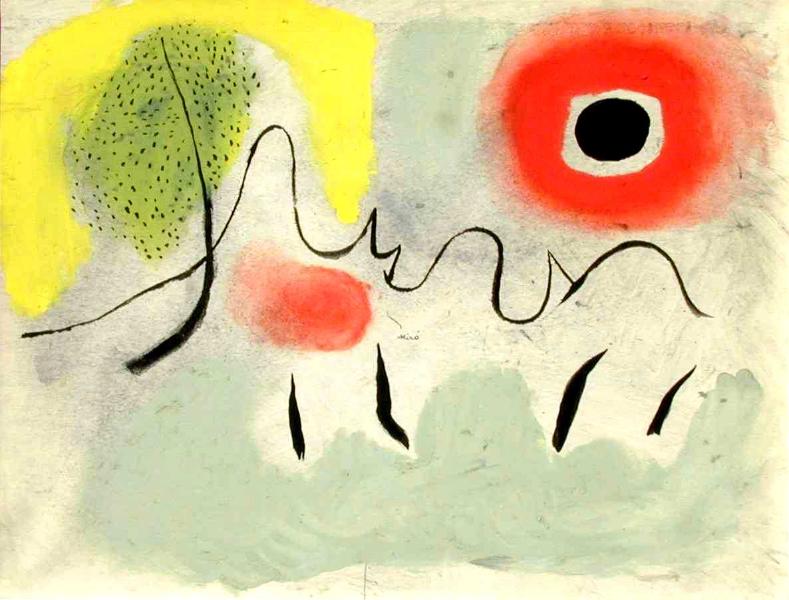الغنائيّة في الشعر العربي
::
تقديم:
إنّ بحث الغنائيْة هو مغامرةٌ بحدّ ذاتها، لأنّ مثل هذا البحث يستلزم العبورَ في مسارٍ طويلٍ ومتشعّبٍ يقودنا، رأساً، إلى غمار التجربة الجاهلية الّتي يتوقّف عليها فهْمُ خصوصيّات الشعر العربي، والقضايا النوعيّة التي ارتبطت به، إنتاجاً وتلقّياً.
واليوم، نفهم لماذا نُعِت الشعر العربي بأنّه “شعر غنائيّ”، ولاسيّما من المستشرقين المتأثّرين بالإرث الأرسطي (=نسبة إلى أرسطو طاليس)، أو بالأحرى بالثلاثيّة اليونانية المنسوبة إلى أرسطو)ملحمي، تراجيدي، غنائي(. وإذا كان ذلك اكْتِشافاً في سياق اهتمامهم ب “الآخر الشعري”، إلّا أنّه سرعان ما أصبح حجاباً يُغطّي أكثر ممّا يكشف، بعدما صار يُقْصد ب”الغنائي” ـ الّذي لم يرِدْ ذكره في كتب القدماء من نقّاد وبلاغيّين ـ البعد العاطفي أو الوجداني الصرف، حتّى غدت كلّ قصيدة رومانسيّة أو وجدانية غارقة في “السنتيمنتاليّة” أو عاطفية تحاكي الموسيقي وتسعي إلى الطرب والتطريب قصيدةً غنائيّةً، وليس بتلك الّتي يمكن أن تتجاوز ذلك إلى أوضاع شعريّة تتأرجح بين “المطلق” و”الملحمي” كما تُرشدنا إلى ذلك قصائد من الشعر القديم والحديث على السواء. وقد أشاع مثل هذا الفهم الخاطئ والمضلِّل، فيما بعد، الجهلة بعلم الشعر، وكتبة قصيدة النثر العربية المجاهرون بعدائهم الشديد للغنائية، الذين يرون فيها عودة إلى الوراء وكُفراً بالتقدم الذي حقّقته الحداثة، لأنّها ـ في نظرهم ـ )مفرطة في الموسيقيّة) و(ذاتية) و(حماسية) أو(جياشة المشاعر)!
من هنا، ورفْعاً لكثير اللّبس وليس اللّبْس كلّه، نُعيد إدماج موضوع الغنائيّة في إشكاليْة جديدة تضيء الوضعيّة الإبستيمولوجيّة لها من حيث مفهومها ومحدّداتها، سعياً وراء نمذجتها أو، بالأحرى، محاولة نمذجتها.
إستشكال الغنائيّة:
نُقارِب الغنائيّة كخطاب شعريّ تتحدّد بنياتُه وفق المبدإ الأنواعي الّذي ينتظمها، مُحترسين من أن نُماثل الغنائية بالشعر أو بالقصيدة تحديداً، بعدما كان يلوح دائماً أنّ القصيدة الغنائية تختصر الشعر بأسره، أو هي تسميته الأخرى، بسببٍ من عراقته في الإمبراطوريّات الشعرية الباذخة، ومن هيمنته في جميع الثقافات الشفوية والمكتوبة، ثمّ من عودته المظفّرة داخل التأويل الرومانسي بعد أن صار “هو الشعر الأكثر سموّاً وتميُّزاً عن غيره” في تعريف سْتِوارْتْ ميلْ 1. وما زلنا نرى ـ منذ ما يزيد عن قرن ـ أنّ هذا الشعر ” الأكثر سموّاً وتميُّزاً” هو، تحديداً، نمط الشعر الذي ألغاه أرسطو من كتابه “فنّ الشعر”. بالنتيجة، كان سؤال الإشكالية: ما هي القصيدة الغنائية؟ يحلّ محلّ السؤال: ما هو الشعر؟
إنّ مفهوم الغنائية في الشّعر، شأنه شأن المفاهيم الأكثر شيوعاً واستخداماً، يكتنفه اللّبس والغموض، وقد وجدنا كم كانت “تتضارب الآراء في تلقّي الشعر الغنائي من حيث خصيصته النوعية ووضعه تجاه باقي أنواع القول الشعري والبليغ عامة”2، فمنهما ما أعرض عن محاولات تعريفها أو تحديد طبيعتها العامة، لأنّ ذلك لن يجلب إلّا تعميمات تزيد الإشكالية تعقيداً، ومنها ما كان يسعى إلى تعريفها عبر عرض الخصائص الأخرى التي لا تمتّ إليها بصلة، كما في رأي نورثروب فراي، مثلما لا ننسى فرضيّة سابير ـ هورف المثيرة للنّظر: قد نضطرّ إلى إهمال بعض أبعاد الشعر الغنائي، لأننا ببساطة لا نملك مفردات حريّة بالخوض فيها؛ بل إنّ بعض المعاصرين ينظر إلى الغنائية على أنّها “مصطلح مستنفد”، أو يُصرّح ب” احتراق الغنائية” أو “أفولـ” ها في ظلّ صعود الشعر الدرامي.3
وتزداد وضعيّة الغنائية في السياق العربي تعقيداً ، وذلك لمّا تماهت الغنائيّة بالشعر، وهو ما ألمح إليه جمال الدين بن الشيخ،الّذي خصّ الإنسكلوبيديا العالمية بمقالة لمّاحة حول )الغنائيّة العربية(، بقوله: “إلى حدود القرن العشرين للميلاد، ظلّ الأدب العربي ينْتسِبُ في جوهره للشّعر، ويلتبس تطوُّر الغنائيّة مع تاريخ الشّعر، تلك الّتي تجدها تعبيرها الأكثر تمثيلاً في القصيدة “.4
تفرض مثل هذه الاعتبارات جملةً من الأسئلة في سياق بحث الغنائية، من مثل:
ـ هل يمكن بحث “المسألة الأنواعية” للغنائية في الشعر دون تحديد مفهوم النوع الغنائي؟
ـ هل يمكن القول ب”أنواعيّة العنائية” دون إدراكٍ لغيْرها من أنواع الأدب داخل الثلاثية اليونانية المأثورة عن أرسطو؟ ثمّ داخل القسمة العربية التقليدية: شعر ونثر؟
ـ إلى أيّ حدّ نتقدّم في البحث من غير أن نستدعي خصائص الغنائية ومقوِّمات تكوين نسقها الدّاخلي، من مثل البناء والإيقاع والنظام التلفّظي والنفسي والتيمات، ومن ثَمّ أن نستوعب البنيات النصّية الجامعة للغنائيّة، والمميِّزة لها عن غيرها؟
ـ كيف تتمظهر الغنائية في شعرنا العربي، في ضوء التحوُّلات التي طالت القصيدة وأطرها الفنّية؟
ـ كيف نتلقّى نصوصاً من الشعر العربي الحديث والمعاصر لا تُعلن عن نفسها بسهولة؟
ـ ألا يستوجب وضع المفهوم تعيين نمذجة أنواعيّة قادرة على تمثُّل واستيعاب اختلاف النصوص الشعرية وتعدّدها؟
نثير هذه الأسئلة بغرض الوعي بالوضعيّة الإبستيمولوجية للغنائية، خارج أيّ ادِّعاء بالتبسيط والاستسهال. وإذا ليس بوسعنا، في هذا المكان، أن نخوض في هذه الأسئلة المستشكِلة لموضوع الغنائية، فإنّنا نسنح الفرصة للملمة بعض القضايا المنهجيّة والمعرفية الّتي نرى أنّ لها أولويّةً ولما في اعتبار من أجل المساهمة في تحديد مفهوم الغنائية وخواصّها ومقوّمات بنائها الداخلي.
الغنائيّ والغنائيَّة:
لا نعثر على ذكْرٍ للغنائية كغرض أو نوْع في تصنيفات القدماء في الشعر العربي، إلّا ما يتّصل بالغناء في حالة إنشاد القصيدة كما هو مأثورٌ عن الشاعر حسان بن ثابت في قوله:
تَغنَّ بالشعرِ إمـَّا كنتَ قائلـَهُ ** إنَّ الغناءَ لهذا الشعر ِ مضمارُ
ما دام أنّ تصوّر هؤلاء لم ينْبَنِ على مقولة الأنواع أكثر ممّا قام على مقولاتٍ أغراضيّة وعروضيّة. لقد انتسبتْ مقولة “الغنائي” إلى الثلاثية اليونانية(ملحمي، تراجيدي، غنائي)، حتّى وإن كان أرسطو نفسه لم يدمجْها في استراتيجيّة بنائه للأنواع التي بدتْ له مائزةً في عصره كالمأساة والملهاة والملحمة. لذلك، يظهر أنّ تاريخ تداول “الغنائيّة” و”النوع الغنائي” في الشعر بدأ فعليّاً مع الإرث ما بعد الأرسطي، واتّسع مع صعود الرومانسية بأوربا، ولا سيّما في ألمانيا وفرنسا.
في تعدُّد التفسيرات المختلفة للثُّلاثية لمْ يُفْضِ الأمر إلى تحديدٍ واضحٍ ودقيق للشعر الغنائي الّذي ظلّ يُعرف بتحديدٍ موضوعيٍّ هو، غالباً، ترجمة للأحاسيس والعواطف، ولم تُحدَّد له ـ عكس الملحمة والدراما، صيغة خاصّة أكثر منها عائمة وسلبية (= كلّ ما ليس سرديّاً أو دراميّاً). ويلتبس الفهم أكثر في ثقافتنا الشعرية لمّا أُعيد تداول وإنتاج المقولة بصيَغٍ فضفاضة ومتعدّدة لدى العديد من الشعراء ونقّاد الشعر، بدءاً من الاتّجاهات المحسوبة على المذهب الرومانسي، حيث تمّ مماثلة الغنائيّ بمقولات الوجداني والذاتي والعاطفي.
وفي ظلّ تطوُّر الدراسات الحديثة داخل نظريّات الأنواع الأدبية وتحليل الخطاب والشعريّة، أنجزها نقّادٌ أوربيّون (جيرار جينيت، تزفيتان تودوروف، كيت هامبورغر، جان ماري شيفر،إلخ)، طُرحت تصوّرات مغايرة ومتقدّمة أعادت قراءة الغنائية، فبدل أن يُستبدل التقسيم الثلاثي (الملحمي ـ الدرامي ـ الغنائي) بالتعارض القديم بين الشعري والنثري، يُفضي الأمر اختزالاً إلى تقسيمٍ ثُنائي: محاكاة وتخييل، على أساس السّردي. هكذا يُرجع الغنائي، المصطلح الثالث من الثلاثية، إلى مقولة النوع “غير التخييلي” الّذي يتحدّد بأنّ ” أنا ـ الأصل” فيه هو الشاعر نفسه، ذلك الذي يتكلّم في خطابه ب”ملفوظٍ واقعيّ” لا ب”ملفوظ تخييلي”؛ وبالنتيجة، يُرجع الأنا الغنائي إلى التلفّظ التاريخي أو المرجعي. ويستتبع ذلك تحليل طرائق بناء الملفوظ في ضوء الخيارات الأسلوبية والجمالية الّتي تحتمي بها الذّات في تنظيم دوالّ القصيدة وقيمها المهيمنة الخاصّة بإنتاج خطابها الشعري، وهو ما يقودنا إلى اعتبار مقولة الغنائيّ تتوكّأ عليها التجربة الجمالية، ولا تسهم إلّا بالحدّ الذي يُحدّد هويَّة النص. فكما أنّ تصوُّر “الدرامي” يُسهم، بديهيّاً، في التعرُّف على العمل كمسرحية، يكون “الغنائي” هو الوظيفة المهيمنة في الشعر.
السّمات العامة للغنائية:
من هنا، وبمنأى عن كلّ وثوقيَّة، نصدر عن فَهْمٍ يرى إلى النوع الغنائي من خلال السّمات التي ينشأ عنها مثل باقي الأنواع، ويمكن للقارئ أن يحدسها وإن كان يجد صعوبةً في تبرير تصوُّره، لكنّ القول بأن هذا العمل “درامي” أو “ملحمي” أو “غنائي” يتجاوز كثيراً ميدان القراءة المباشرة، ويُقيم في ذاته الفعل النقدي المستند على المعارف التاريخية والنظرية. هذه السمات الّتي تُجْمل ـ بهذه الدرجة أو تلك ـ النوع الغنائي، أو بالأحرى القصيدة الغنائية، هي:
أوّلاً ـ أنْ تأتي القصيدة في العموم قصيرةً وموجزةً وبالغة الكثافة، لكنّها قد تزيد على ذلك إذا رأى الشاعر فيه بلورةً لصوته الإنشادي وموقفه الغنائي داخل القصيدة ومعماريّتها العامة.
ثانياً ـ أنْ تعبّر عن “الأنا ـ الأصل” للشاعر الّذي يتكلّم بقدرما يُفصح عن تجربته الداخلية، صوته الداخلي، عالمه الداخلي بكلّ ما يفضّ عنه من روح جيّاشة في التعبير.
ثالثاً ـ أنّ تتحرّك في سياق نوعيّ ومتنوِّع من التيمات والرؤى المنتجة للمعنى الشعري، التي تستدخلها أنا الشاعر (الحبّ، الرثاء، الإشراق الصوفي، سخاء الطبيعة، مجالس اللّذة والشراب،إلخ).
رابعاً ـ أن تنقل مجمل القيم الخاصّة بإنتاج “كوْنٍ دلاليٍّ” يفتح الأنا الغنائي على الأشياء والعالم، فلا تُقيم فصلاً بين الداخل والخارج، الذّات والآخر، المحسوس والمجرَّد في مزيجٍ خلّاقٍ يخلق وحدة الموضوع، ووحدة البناء، ووحدة الانطباع المتأتّاة من ذلك جميعاً.
خامساً – أن تكون شفّافةً وعالية التركيز في تدبير نسقها الدّاخلي، لأنّ القصيدة الغنائية تبقى قريبة من الغناء، ومن شفافيّة الغناء بالنّظر إلى نوعيّة بنائها المعماري ككلّ.
سادساً ـ أن يأخذ فيها الإيقاع وضع “الدالّ الأكبر”، لأنّه ينظّم معنى الذّات في خطابها، ويُنْقذ البناء النصّي من التبعثُر والتفكُّك عبر آليّات التكرار والتقفية والتوازي والهندسة الصوتية وتذويت الدّلالة.
سابعاً ـ أن تتخفّف من “الملفوظ التمثيلي”، ومن السّردي الّذي قد يُشيع الروح الدراميّة داخل النصّ، وإن كان ذلك لا يمنع أن تهجر نقاءَها الأنواعي، فتستثمر “الملحمي” في علاقتها بالتاريخ والأسطورة والرمز. ولقد رأينا قصائد كثيرة حملت دلالاتٍ وأبعادٍ غنائيّة جديدة ضمن سياق النص الشعري العربي الحديث وثقافته الجديدة.
إنّ هذه السمات استدلاليّة مشتركة بين نصوص “الغنائيّة” في الشعر، وإذا كانت تمثِّل حدّاً معقولاً من تمثيليّتها ونجاعتها، فهي مع ذلك لا تزعم الإلمام بها، بالنّظر إلى اختلاف تقاليد الكتابة والأسلوب، إذ لكلّ شاعر حقيقيّ أسلوبه، أي عالمه الخاصّ.
تتجاوز الإشكالية المستوى الأنواعي الكلاسيكي المتمثّل في المقارنة بين الشعر والنثر، وتصنيف الشعر ضمن تصنيفات الأدب، إلى مساءلة النسق الأنواعي الداخلي للغنائيَّة ذاتها، ما دُمْنا نعتبر النوع الغنائي ليس سلطة معياريّة قبلية ولا ـ تاريخيّة متعالية على الزمن، لأنّ النوع ذاته نسق داخليّ متحوّل لا يوجد إلّا من خلال النصوص التي تعْبُرها وتُعبّر عنها الذّات في تنظيم معناها داخل الخطاب.
الغنائيّة بوصفها خطاباً:
إنّ استشكال الغنائيَّة، وتبعاً للمفاهيم والمقولات المحدّدة له، يدعونا إلى تبنّي مفهوم الخطاب لنقرأ به أشكال الطرائق الّتي تسند تدبير المبدأ الأنواعي الأنواعي للغنائية في الشعر. إنّ الخطاب، هنا، استراتيجية. من جهةٍ أولى، يجعل الخطابُ نصَّ الغنائية مُنْدرجاً في نسق أكبر منه وهو النوع الأدبيّ بالقياس إلى التزام النصّ بقواعده والسمات المكوِّنة له، ومن جهة أخرى، يُحيلنا الخطاب على سياقه التلفُّظي المفرد باعتباره مفتوحاً على وضعيّات التواصل ومقاصد التلقّي والتأويل. إلى ذلك، علينا أن نُراعي بنية الخطاب في الشعر تحديداً، التي تحمل في ذاتها ـ بما هي مكوِّن دلاليّ ـ عناصر تكرارها أو عناصر انحلالها وزوالها. فعناصر التكرار تُدْرك من خلال ما بين أجزاء البنية الدلالية من علاقات ارتباطية يقتضيها منطق النصّ، ويستدعيها أيضاً مبدأ الانسجام ليس باعتباره من مبادئ النصّ المنجز، بل هو من مبادئ الخطاب لمقايسة شعريّة النص من عدمها.
إنّنا لمّا ننظر إلى الغنائية بوصفها خطاباً، يُراد منّا أن نبحث في بنْيته التي توجِّهها البنيات النصّية. وإذا كان التزام النصوص الشعرية ببنيات النوع الغنائي ليس التزاماً كلّياً ولا زمنيّاً، فإنّه يحدث أن تخرج النصوص، أو تحاول أن تخرج، عن مقتضياته جزئيّاً أو شبه كلّي، بحسب أنساق الكتابة وشروط إنتاجها وتلقّيها، كما هو الحال في الخروج على المقدّمات الطللية، أو في الخروج على النمط الأصلي للبيت الشعري، أو في خروج تنويعات الأسلوب الشعري على التئام الذّات وأحاديّة الشكل الكتابي. ويجدر بنا هنا، أن نعي بأنّ اشتغال الغنائية أكثر من وظيفتها لا يتحدّد إلّا داخل خطابها الخاصّ، أي جميع القيم والخصائص المهيمنة الخاصّة بها، وهي:
الذّات:
تُشكّل الذَّات عصب الغنائية وحافز انبنائها داخليّاً، وقد شاع في نظريّة الأنواع الأدبية أنّ الشعر الغنائي هو شخصية الشاعر نفسها، أو هو الأثر الأدبي الذي يتكلم فيه الشاعر بمفرده، ولذلك فإنّ الذي يتكلم في الشعر الغنائي إنّما هو الشاعر وأناه الأصلية الّتي ترتبط ب “ملفوظٍ واقعيٍّ”. فإذا كان كلّ ملفوظٍ “واقعيّاً” على نحو خاصّ، فإنّ “واقع” الملفوظ ينشدّ إلى تلفُّظه من خلال الذّات الحقيقية والأصلية. هذا ما تُفيدنا به نظرية التلفّظ. يكتب كيت هامبورغر: ” إنّ اللغة الإبداعية التي تُنْتج القصيدة الغنائية تنتمي إلى نظام اللغة التلفُّظي، وهو السبب الرئيسي والبنيوي الّذي من خلاله نتلقّى القصيدة باعتبارها نصّاً أدبيّاً، أكثر من كونها نصّاً تمثيليّاً، سرديّاً أو دراميّاً. نتلقّاها كملفوظٍ لذاتٍ متلفِّظة. إنّ الأنا الغنائية، حتّى وإن كان متنازَعاً حولها، هي الذّات المتلفِّظة”. وفي ما يخصّ الجدال حول مطابقة الأنا الغنائية بالكاتب كشخص، يؤكّد هامبورغر أن ذلك لا يتمّ إلّا في المستوى المنطقي بدون أن نحكم مسبقاً على أيّ علاقة بيوغرافية أنّى كانت، وتضيف: “بطبيعة الحال، يمكن أن تكون التجربة تخييليّةً، بيد أنّ ذات التجربة ـ ومعها الذات المتلفِّظة والأنا الغنائية ـ لا يمكن أن تكون إلّا حقيقيّةً”5. وهذا ما ذهب إليه أدورنو عندما اعتبر أنّ “من يتكلّم داخل الفنّ هو ذاته الحقيقية، وليس الذّات التي تُنْتجه أو تتلقّاه”6. وفي عبورها من المحور اللّساني إلى الأدب، والشعر أساساً، تمتدّ الذات من استعمال عوامل التلفُّظ إلى الانتظام في نسق الخطاب بأكمله. داخل الخطاب، تصبح الذات تاريخيّة اجتماعيّاً وفرديّاً، ومن ثمّ تتمظهر الذّات المتلفظة كعلاقة أو جدل بين الفرديّ والجمعيّ.
إنّ الذات مفهومٌ لسانيّ، أدبيّ وأنثروبولوجيّ، ولن تلتبس مع مفهوم الفرد الذي هو ثقافيّ وتاريخيّ يرجع إلى تواريخ التفرّد. من هنا، يجب الحذر من الحدوس النظرية في الشعر الّتي تُحيّد اجتماعيّة الفرد ـ الذات ـ المؤلف، فإصغاء الذات هو إصغاء للجمعي بقدرما هو إصغاء للتاريخ7.
وقد رأينا، عبر تاريخنا الشعري الذي يظهر كحديقة ملأى بالألغاز والأسرار ـ بتعبير المستشرق ريجيس بلاشير، كيف أنّ الشاعر “يمنحنا ذاته في إنسانيّته وبكلِّ نقائصه، وهو في ذلك يحرص على ألّا يسحقه المجتمع الذي يعيش فيه”8، لأنّ المجتمع يهابُ أو يخشى من ذات الشاعر باعتباره ممثِّلاً للفرد ورمزاً له، فيما كان هو لا يخشى المجتمع الذي ما فتئ يسعى إلى سحقه: مثلاً، ينشغل زهير بن أبي سلمى في معلَّقته بتأكيد حاجة مجتمعه، لأسباب اقتصادية، إلى السلم الذي راح يُفلسفه، أو حاجة عنترة العبسي إلى تأكيد ذاته وذوات كلّ العبيد في مجتمع السادة الذي كان يحول بينه بين حريّته، وإحساس طرفة بن العبد بالمفارقة الحادّة بين الحياة والموت في بيئته الوثنية، وكيف أنّ الشعراء الصعاليك بادروا إلى السلاح في وجه المجتمع الذي يُمارس تغريباً في الحياة على ذواتهم. كما رأينا، بعد ذلك بقرون، كيف امتلك السياب والبياتي ومحمود درويش وأمل دنقل وعياً حادّاً بالتاريخ الذي أعادوا صهره وصياغته في أفق ابتعاث الذّات الجماعية من عجزها. إلّا أنّنا نرى، اليوم، في شعرنا الراهن الذي ترفده قصيدة النثر، نمطاً من الذاتيّة يخرج عن أنماطها السابقة، بحيث صارت الذاتيّة تتجسّد في “الصوت الفردي الحميم، والذات الصغيرة في خوفها ولا يقينيّتها وتردُّدها، وفي أحلامها الكسيرة وتشوُّفها لعالمٍ أكثر عذوبة ورأفة وأقلّ هدير”9.
بهذا الاعتبار، فإنّ التمظهرات الخاصّة بالذّات والذّاتية التي تنتجها الأنا الغنائية وتبلورها داخل نظامها التلفّظي، يجب أن تُحلَّل بناءً على مبدأ نسق الخطاب كاشتغال للُّغة يثوي فيه “بُعْد الحياة” من لدن هؤلاء الذين يتكلمون. هكذا تبقى الغنائية الميدان المميَّز لعمل الذّات وتعبيريّتها، في انحيازها للغناء كشرط لشفافية التعبير في الشعر، بمقدار ما أنّ ” الرؤية الغنائية للعالم، أكانت عدوانية أو أخوية، تستمرّ على هذا النحو عن طريق السحر السامي للكلمة”10.
الإيقاع:
لقرونٍ طويلة، استمرّ تعريف الشعر الغنائي بأنّه “مجموع القصائد الشعرية التي تُرافقها القيثارة”، ومن ثمّ ارتبط هذا النّوع من الشعر، في الوعي الثقافي والنقدي العامّ، بالموسيقى والغناء. نحن بدورنا لا ننفي القول إنّه ” علينا أن نتذكّر أنّ الموسيقى، في التحليل الأخير، هي جوهر الغنائيّة”، بتعبير صلاح فضل 11، لكن علينا أن ننظر إلى هذا الشعر داخل اشتغاله كنصّ لغويّ وجماليّ، لنُدرك مركز الثّقل الذي للموسيقى، أو بالأحرى للإيقاع الّذي يتجاوز العروض، ونُدرك خاصية الغنائيّة التي يأخذ فيها الإيقاع نفسه وضع الدالّ العضوي والجوهري بالمعنييْن الفكري والجمالي. وإذا كان الغنائية لا تزال مُحاطةً بتاريخٍ من اللّبْس والغموض، فإنّ ذلك ـ في تقديري ـ يأتي من اللّبْس الّذي شاع حول الإيقاع، والعكس بالعكس.
هنا، يجب أن نميِّز بين الإيقاع والعروض، فنعتبر الأول أوسع وأشمل للثّاني القابل للعدّ والقياس. فإذا كان العروض يُسعفنا في ضبط البنية الوزنية للبيت الشعري، فإنّ ليس له ما يُقدّمه في تحليل إيقاع الخطاب باعتباره المجموع التركيبي لكلّ العناصر التي تُسهم فيه، والتي تتمظهر في كلّ مستويات اللغة الشعرية: العروضية، النّظمية والدلالية التي تُحدّد دالّ الإيقاع وطبيعة اشتغاله داخل القصيدة الغنائية. وفي هذا السياق، يرشدنا هنري ميشونيك إلى أنّ “الإيقاع بالغ الأهمية داخل اللُّغة بدلاً من الزجِّ به في العروض، العروض الّذي يقيس الأزمنة التي ليست لأحد، لأنّها ليست لا زمن المعنى، ولا زمن الذات”.12
لذلك، لا يُعرَّف الإيقاع بوصفه وزنيّاً أو صوتيّاً أو نبريّاً فحسب، وإنّما يتعدّى ذلك إلى الخطاب بأكمله، حيث يمكن أن يستند إلى الأبعاد الدلالية للنّظْم بمفهومه البلاغي، وذلك تبعاً لـ “حركة المعنى” وفعاليّته في تنظيم الذات داخل خطابها، المفرد والمختلف. وهذا ما يجعلنا نعتقد أنّ الإيقاع دائماً ما شكّل مختبر المعاني والرؤى الجديدة التي لم تكفَّ الذّوات، من عصر إلى آخر، عن السعي إليها في تواريخ تفرُّدها الخاصّة. هناك تاريخ لإيقاعاتٍ أو “عُقَدٍ إيقاعيّة” لكلّ من المتنبّي وابن زيدون والسياب ونازك الملائكة ومحمود درويش وأدونيس وسعدي يوسف وقاسم حداد، تمثيلاً لا حصراً. فالإيقاع ليس عنصراً شكليّاً أو مستوى أو حليةً أو مُضافاً، بل هو مبدأ بانٍ ودلاليّ يتشكّل عبر مسار إنتاج الغنائية لمعناها، مجهول معناها.
المعنى:
على مبدأ المحاكاة تمّ التمييز بين الغنائي والملحمي والدرامي. وفي الصفحة الأولى من كتاب أرسطو طاليس “فنّ الشعر”، نجد تحديداً واضحاً للشعر، فهو فنّ المحاكاة (وبصيغة أدقّ عن طريق الوزن واللغة والموسيقى)، مستثنىً منه ما أنتجه أَمْبِيدُوكْل من آتارٍ كتابية تعرض بواسطة الأبيات (الموزونة) موضوعاً في الطبّ أو في الطبيعيات، بمعنى أنّ أرسطو يرفض ما يُسمّى بالشعر التعليمي، أي الشعر الّذي يفقد شعريّته في ما هو خارج الشعر13 .ولقد انتبه القسّ باتو فيما بعد إلى حصر المحاكاة في “محاكاة الفنون الجميلة” التي تخضع للمبدإ نفسه، بما فيه الشعر الغنائي الّذي يتوزّع في فنون صغرى متنوّعة ومشتقّة منه. وقال ” إذ كلًّما تواصل الفعل كان الشعر ملحميّاً أو دراميّاً، وإذا انقطع وأصبح يرسم الحالة الوحيدة للرُّوح وإحساسها المجرَّد كان الشعر غنائيّاً: ويكفي في هذه الحالة أن نضفي على الشعر الشّكْلَ الملائم حتى يدخل حيِّز النشيد”، معتبراً أنّ الشعر الغنائي يختلف عن غيره من الأجناس الشعرية، ويتميّز عنها بخاصية واحدة: وهي موضوعه الخاصّ.فإذا كان موضوع تلك الأجناس يتمثّل أساساً في الأفعال، فإنّ الشعر الغنائي يختصّ بالأحاسيس، فهي مادّته وموضوعه الأساسي14.
وقد تكون هذه الأحاسيس المعبَّر عنها في الغنائي متصنِّعةً أو أصيلةً، لكنّها تخضع لقواعد المحاكاة الشعرية، بمعنى أن تكون ممكنة التحقُّق ومختارةً ومكتملة كما هي في حقيقتها. وفي هذا السياق، يجب التّذكير بأن المحاكاة في التراث الكلاسيكي لا يعني التصوير المطابق للأصل، وإنّما هو حالة من الخيال. وقد وجدنا الفلاسفة المسلمين يبنون تصوُّرهم للمحاكاة على مقولة التّخييل، وبالنتيجة على وظائف التّعجيب والغرابة واللذّة التي يستثيرها الشعر في النفس، فأرادوا بمصطلح التّخييل الدلالةَ على معنى المُحاكاة الشّعرية، ونظروا إليه بوصفه العلّة الصُّورية للشّعر، وإلى المعاني الّتي يتضمّنها الشّعر بوصفها علّته المادِّية. وكان حازم القرطاجني يرى أنّ “المعاني التي تتعلق بإدراك الحسّ هي التي تدور عليها مقاصد الشعر(…) والمعاني المتعلقة بإدراك الذِّهن ليس لمقاصد الشّعر حولها مدار”.15 من هنا، أمكننا أن نمرّ من مجرّد إمكانية التعبير الخيالي إلى وضعيّة خيالية أساسية للأحاسيس المعبَّر عنها، وأن نُوصل كلَّ قصيدةٍ غنائيّةٍ إلى النموذج المطمئنّ للحوار الداخلي المأساوي حتّى نتمكَّن من أن ندخل في جوهر كلَّ خلقٍ غنائيٍّ ذلك الفاصل من الخيال الّذي بدونه يستحيل تطبيق مفهوم المحاكاة على الشعر الغنائي، كما يرشدنا إلى ذلك جيرار جينيت16.
إنّ المحاكاة والتخييل فالتصوير الّذي يتمّ بهما تحيل كلُّها على عالم الحسِّيات لا المجرَّدات، ولا يتعلق الأمر بتكرار أو تزييف. إنّ كلَّ واحدٍ منهما يمكن أن ينتج أثراً جيّداً، بما في ذلك المحاكيات المطابقة الّتي يمكن أن تنتج نصّاً جميلاً، لكون المحاكاة تستعين هنا بأمور لفظية ووزنية وتقفوية وأسلوبية. ولهذا الاعتبار، رُبِطت المحاكاة بوجوه البلاغة والمجاز لتوصيل المعنى وتأدية دلالاته بطراائق خاصّة غير عادية، على مستوى التشكيل والتأثير. فهي عمليّة مرتبطة بتقديم المعنى أكثر من ارتباطه بالمعنى نفسه.
لن نتتبّع المعنى في تيماتٍ معلومة ومقرّرة سلفاً، ونختصرها في نموذجٍ لغويٍّ فجّ. فالّذي يهمُّ، هنا، ليس المعنى، بل طريقة بلوغ المعنى، لأنّ البحث عن المعنى بمفرده مستقلّاً عن طريقة بلوغ المعنى أو عن البنيات، هو البقاء مقدّماً في مستوى الدّليل. لذلك، علينا أن نسأل: ما هي وضعيّة المعنى في خضمّ الممارسات الدالّة للغنائية في الشعر؟ وما قوانين وآليّات بنائه واشتغاله الداخلي؟ وما علاقة المعنى ببنية النصّ، وسياقه وتداوله؟ وغيرها من الأسئلة التي يفرضها الوضع الاعتباري للمعنى داخل النصّ الشعري عامة، والغنائي تحديداً. لكنّ تفكيراً جادّاً ومختلفاً يجب أن يتجاوز الوضع الّذي ربط المعنى بميتافزيقاه، بالتعليم النفساني للأدب، وأن يبحث في المعنى بالمعنى الذي يكون فيه، بالنسبة لشعريّة الخطاب، باثّاً للدلاليّة التي تتجاوز الدليل المعجمي للكلمات عبر آثار تداعيها مع دوالّ أخرى، فلا ينفصل المعنى عن الذّات والإيقاع. إنّها، جميعاً، رهن علاقة تضمينٍ متبادلة داخل الخطاب، ومتحوّلة باستمرار.
فإذا كنّا، في مرحلة أولى من البحث، ملزمين ببحث طبيعة الغنائية وعناصرها وآثار تشكُّلها في الخطاب، فإنّ ذلك لغاية إبراز عمل الذّات وهي تخترق اللغة بأقصى عنفوانها، وتبني المعنى، المعنى المغاير للمعنى المعجمي، حيث يقول معنى الغنائيّ، بطريقة الخاصّة، أهواءنا ورغباتنا وأشواقنا وخوفنا وطريقتنا في طرد هذا الخوف.
بهذا المعنى، يُفيدنا مفهوم الخطاب في التعرُّف على أشكال التجاوز التي كانت تحدث داخل مقتضيات النوع الغنائي وأنساقه العامة. ويسمح لنا هذا الشكل من التجاوز بمتابعة الغنائية كـ “شكـل حياة”، وبرصد صيغ الثبات والتحوُّل الحادثة في البنيات أو غيرها. نكون، هنا، بصدد العبور من غنائيّةٍ إلى أخرى وفق استراتيجيّة الخطاب لدى هذا الشاعر أو ذاك، حيث لا يتمّ تحليل القصيدة إلّا باعتبارها كاشفةً عن اشتغال المبدأ الأنواعي للغنائية، وعن اشتغال الدوالّ المهيمنة التي تفجّر شعريّة الغنائيّة.
قراءة الغنائيّة: محاولة نمذجة
تُفيدُنا هذه المداخل النّظرية، في هذه اللَّحظة من تطوُّر شعرنا وما يستتبع ذلك من تبلور أشكالٍ متنوّعة ومخصوصة من الغنائيّ، أن نقارب الغنائيّة / الغنائيّات من خلال نمْذجةِ تستوعب مجمل الخصائص والسمات الناظمة لها، بحسب أساليب الكتابة ورؤى العالم والخيارات الجماليّة الّتي ينتهجها شعراء العربيّة، من ذاتٍ إلى ذات، ومن شرْطٍ إلى آخر.
إنّ أيّ محاولة نمذجة الغنائية” يقتضي، في الأعمّ، اكتشاف البنيات النصّية والأسلوبية والرمزية الّتي تحتضنها، ولا يتمّ ذلك إلّا من خلال تصوُّر واضح يسندها على تجريبيّة نصّية ذي تمثيلية متنوّعة وعابرة للتاريخ الثقافي للشعر. وأوّل شروط هذا التصوُّر تجاوز إشكال التعالي الأنواعي المحصور في شروط النظرية ومفاهيمها المجرَّدة إلى محايثة الموضوع الغنائي من خلال مبدأ التنويع بوصفه مكوِّناً نصّياً يتمُّ تحديده عبر التماثلات النصّية التي يُعاد استثمارها وتحويلها وتأويلها في إطار ما يُسمّى بلعبة التكرار والمحاكاة والاقتراضات بين النصوص. يسمح لنا ذلك بالتعرُّف على الغنائية باعتبارها خطاباً يرتبط بأنساق الكتابة وفعّاليتها في التاريخ والثقافة، ويدعونا إلى توسيعها وبناء مقتضيات قراءتها وفق سيرورة نسقيّة ـ تأويليّة تستوعبها في نمذجة معقولة تتفرّع عنها جملةٌ من التصنيفيّات الأساسيّة، بحسب الدرجة والنوع:
أ.تصنيفية بحسب معيار الزمن (قديم، حديث ، معاصر).
ب. تصنيفية بحسب معيار البناء (بسيط، مزدوج ومركّب).
ج.تصنيفية بحسب معيار الشكل (عمودي، تفعيلي، نثري ).
د.تصنيفية بحسب معيار التلفّظ (محاكاة، تخييل).
هـ. تصنيفية بحسب معيار المهيمنات (الإيقاعية، التيماتية، الأسلوبية..).
و. تصنيفية بحسب معيار التلقّي (التلقائي، الجمالي، التأويلي).
تظهر التصنيفيّات متداخلة ومتراكبة ومن الصّعب أن نفصل بينها، وقد اعتمدّنا في وضعها على مبدأ التجانس وخاصية التمثيليّة بالقياس استشكال الكثرة والاختلاف والتعدّد. ويكون موضوع النمذجة، بالتالي، تعيين العلائق والاختلافات التي يُظهرها تعدُّد النص الشعري العربي واختلاف بنياته.
هكذا، نحاول أن نقدّم نمذجة أوَّلية تستوعب عدداً من صيغ الغنائية وحساسيّاتها، منها ما ينضبط للتيمات الأغراضية أو الدلالية (الفروسية، الطبيعة..)، ومنها ما ينشغل ببيان الفروق النوعية الحاصلة بين أكثر من شاعر بصدد موضوعٍ بعينه (الحبّ، النُّزوع الصوفي..)، ومنها ما يشرط المعنى باجتماعيّته (الحرب والسلام، الرثاء، الغزل العذري..). ومنها ما يُقارب النوع الغنائي في علاقته بأنواع الأدب والمعارف الأخرى (القرآن، الأسطورة، الرموز والنماذج الأصلية، تقنيات المسرح والحكي..). وذلك تبعاً لمقولات مرنة تسمح بوضع مختلف تجارب الغنائيّة الكبرى في الشعر العربي على محكّ استراتيجية الخطاب، لمُقايسة مكوّناتها الأسلوبية والجمالية، ودرجة توتُّرها بالموضوع الغنائي.
إنّنا، هنا، بصدد الغنائيَّة كواقعةٍ جماليّة وتاريخيّة ترتبط بأنساق الكتابة في غير عصر وثقافة مُعطييْن، وبشروط التلقّي. فمقولة الغنائية ـ أكثر من غيرها ـ تُظْهر هذا الجوهر الأكثر وضوحاً، العابر للذّوات والأزمنة: أليْس تعتبر أوصاف الطبيعة في رحلة الجاهلي غنائيّةً متنوّعة المؤثّر الّذي يُعبّر عن جدل الذّات ـ الصحراء؟ أيُّهما أكثر غنائيّةً، رحلتُه أم رحلة أبي نواس في تجربة اللذّة والانتشاء؟ ألا يأخذ الرثاء في شعر الخنساء وسْمَ الغنائية السوداء التي تصدر عن عاطفة الحداد، في فقْدها لأخيها صخر؟ أيّهما أكثر تعبيراً عن إيقاع ذاتيّته، الشّنْفرى في الالتزام بتجربة اللّا انتماء؟ أم العباس بن الأحنف في انحيازه إلى الشفافيّة للبوح عمّا يعتمل في داخله من جراح الحبّ؟ أم أبو تمام في تجربة العبور إلى الكتابة؟ ثمّ ما الّذي يجمع هؤلاء بأبي الطيب المتنبي الذي تنفتح فيه غنائيّته على درْس الحكمة؟ ثمّ أليس للشعر المقطعي للموشّح غنائيّة خاصّة في احتفائها بسخاء الطبيعة، وما تجده الذّات داخلها من إحساس طافح بالعنفوان؟
وفي الشعر الحديث الّذي فجّرتْه حركة الشعر الحرّ، ألا نجد انْبِثاق غنائيّات جديدة، حيث تختبر الأنا الغنائيّة معانيَ جديدةً غير معزولةٍ عن أشكال تدبيرها للبناء النصّي وأجروميّاته؟ ألمْ تتولّد داخل الأشكال الجديدة من النوع الغنائيّ أبعاداً تستوعب الملحمي والاجتماعي والنفسي تحت وطأة الإحساس بالزمن، وتمثيلات الخراب والغربة والضياع، ليس فقط عند الروّاد من أمثال السياب وأدونيس ومحمود درويش، بل أيضاً لدى محمد الماغوط الذي يقدم إلينا من تجربة قصيدة النثر؟
وإذا كانت الغنائيّة العربية قديماً تُعبّر ـ كما رأى جمال الدين بن الشيخ ـ عن نفسها في ثلاثة سِجلّاتٍ رئيسية: الحب، الطبيعة والفضائل الإنسانية؛ فإنّ في داخلها تكمن قائمة العواطف العظيمة التي تمثل قانون الإنسانية المشترك، ولهي نفسها تمدّ الشعر العربي الحديث بإلْهامٍ لا يستنفدها، وبأبعادٍ قادرة على حمْل دلالات جديدة في سياق اللّغة، التاريخ والمجتمع.هكذا، تظهر الغنائية كأنّها تُحدّد الجزء الأكبر من الشّعر مهما كانت الأنماط الكتابية المُتّبعة. وإذا كان النقّاد ودارسو الشعر لم يألوا جهداً لتحديدها، لكنّها دائماً موجودة في تجارب الشعراء، ودائماً ما تُلْهم تلك الحركة أو الطاقة التي تستخدمها الكتابة الشعرية بحثاً عن شكل مثالي داخل اللغة، أو عن تلك “الغريزة السماوية” كما يوحي بها كمْ شاعرٌ، ويُنْشدها في تباريح الأرض .
ـــــــــــــ
هوامش
1.نقلاً عن جيرارجينيت: مدخل لجامع النص، ت. عبدالرحمان أيوب،دار توبقال للنشر،ط.2، 1986، ص.70.
2.رشيد يحياوي: الشعري والنثري، منشورات اتحاد كتاب المغرب،2001،ص.42.
3.أنظر صلاح فضل: أساليب الشعرية المعاصرة، دار الآداب، ط.1، 1995، ص.86.
محمد لطفي اليوسفي: أفول الغنائية، الثقافي ضمن جريدة الاتحاد الإماراتية، 24 كانون الأول (ديسمبر) 2009، ص.9.
4.ـ جمال الدين بن الشيخ، الغنائية في الشعر العربي، ت. عبد اللطيف الوراري، القدس العربي،السنة السابعة عشرة،ع.5052، 23 آب/غشت 2005، ص.10.
5. Hamburger K.,Logique des genres littéraires,seuil,1986,p.243.
6.نقلاً عن: Meschonnic H.,Critique du rythme,Verdier,1982,p.208.
7.هنري ميشونيك، المرجع السابق، ص.113.
8.ريجيس بلاشير: الشعر العربي، حديقة ملأى بالألغاز، مجلة بيت الشعر في المغرب، 2003، ص.93.
9.كمال أبو ديب: جماليات التجاور، دار العلم للملايين، بيروت، ط.1 ،1997، ص.333.
10.جمال الدين بن الشيخ، المرجع السابق، ص.209.
11.صلاح فضل، المرجع السابق، ص.85.
12.هنري ميشونيك:المرجع السابق،ص.152.
13.أرسطو طاليس: فنّ الشعر،ت.عبدالرحمن بدوي،دار الثقافة، بيروت، ط.2، 1973،ص.6.
14. نقلاً عن جيرارجينيت: مدخل لجامع النص،م.س.،ص.44.
15. حازم القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1981م. ص.29.
16.جيرار جينيت: مدخل لجامع النص،م.س.،ص.45.
التعديل الأخير تم: 05/07/2021