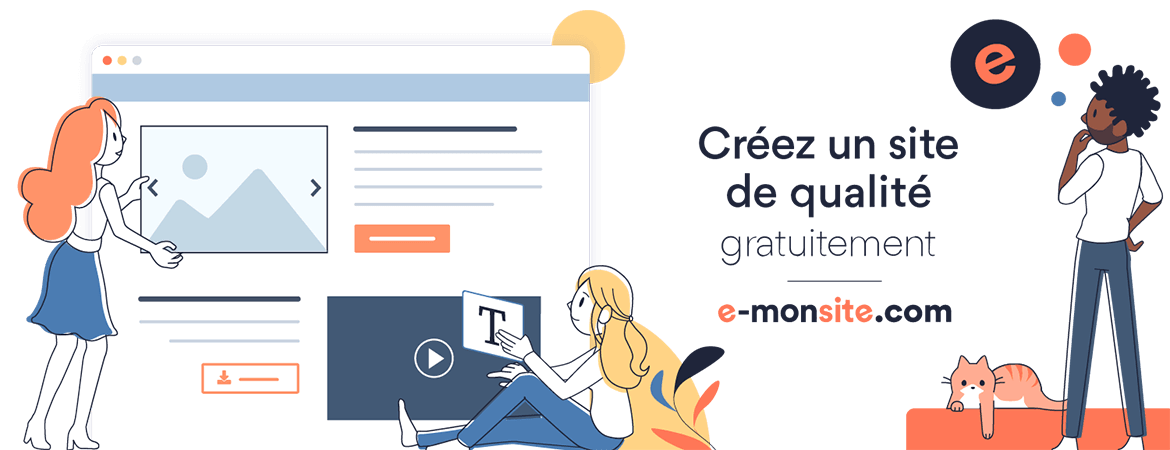الكتابة الشعرية النسائية المغربية كتابة شابّة تُقارب أربعة عقود، إلا أنّها تشهد تحوُّلاً كمّياً ونوعيّاً يرتبط بانفتاح المرأة على المجال الثقافي والفني، وازدياد وعيها بذاتها وحضورها، وطموحها لأن تُحرّر لغتها من تقاليد الكبت اللغوي والجمالي والقمع الاجتماعي، وتوصل صوتها للقُرّاء. ونستطيع اليوم أن نتحدث عن حركية شعريّة نسائية في المغرب، خصوصاً إذا أدخلنا في الحسبان شاعرات الإنترنت وعددهنّ كبير مع يسر الولوج إلى المهبّ المعلوماتي الكوني الجارف، بما يفيده من التفافٍ على كثير من معيقات التداول والانتشار والتحرُّر من أيّ سلطة ورقابة. ورغم تباين مستويات العديد من التجارب الشعرية النسائية، فنّياً وكتابيّاً، فإنّها تمثل بحدّ ذاتها دليل عافية على التنوع والدينامية التي يعرفها الحقل الإبداعي المغربي برمّته.
الجسد معراجاً
عندما نُصغي إلى أهمّ تلك التجارب التي يحفل بها الشعر النسائي المغربي، فإنّه يمكن لنا أن نرصد آليّات تشكُّل الأنا الشعري، وما يترتّب على مُتخيَّله من فهم خاص للذات والأشياء والعالم، يختلف من ذات إلى ذات، انطلاقاً من الجسد في اختلافيّته، ومن الانهمام بالجسد بوصفه يعكس بحثاً عن معنى ما، أو عن قيمة ما، يوجدان دوما موضع اشتهاء وتوق. غير أنّ ما يسترعي انتباهنا في متن الشواعر هو الحضور الطاغي للمرجع الصوفي بأوسع معانيه، سواء في طبيعة اللغة، أو بناء النص وتخييل الجسد والموقف من الذات والعالم. ففي مقابل الصوت الشعري الجمعي لدى شاعرتين رائدتين مثل، ثريا السقاط ومليكة العاصمي، الذي نفّس عن ارتباط التجربة بمشاغل فكرهما السياسي والنضالي وهو يجابه السلطة ويصرخ في وجه الواقع وتكلُّسه وخذلانه، ثمّة انكفاءٌ على النزوع الفرداني للأنا الذي سيقطع مع الهمّ الجماعي لصالح الصوت المفرد المفضي إلى دبيب الذات في مختلف تقلُّباتها وحالاتها الشعورية والوجدانية، إذ يتلبّس بلبوس التجربة الجوّانية أو الجسدية، ويُحوّل لغته إلى لسان حال يسمو بتجربة التَّوْق الصوفي إلى الاكتمال والفناء بعد معاناته حالات الفقد والغياب، مثلما يحوّلها إلى كوكبةٍ نجوم تتلألأ بأثر الجسد وإشراقاته. فهذه الشاعرة أمينة المريني تعمل، في سعيها الدائب إلى المطلق ومعانقته، على تحريرها ذاتها من حمأة الجسد وسجنه، وأناها من سلطة المعنى وتستبدل به معنى مُتحوِّلاً باستمرار يتجاوب مع نزوعها الرؤياوي- الجوهراني بلغة إشراقيّة وغنائية تتلألأ بقوافٍ داخليّة وموازناتٍ صوتيّة، كما بمجازات الكشف والرؤية؛ وهذا ما يتيح للأنا أن يتجوهر في الصميم من هويّتها الكيانية المهدورة، وأن يبصر بضوء المحبة أعماق الحياة، رغم ما فيها من زيف وخداع. تقول الشاعرة في مكاشفتها الثالثة «رقصة»: «كَيْ أخرُجَ من هذا الجَسَدِ الوَهَجِ/ الجَسَدِ الغَنَجِ/ الجَسَدِ الثَّبَجِ/ كَيْ أدخُلَ ذاتَ الصَّفْوِ/ وذاتَ الصَّحْوِ/ ستَلْبَسُني ثانيةٌ/ أَخْتَزِلُ العُمْرَ الجَمْرَ/ العُمْرَ الخَمْرَ/ بِكَأْسٍ لا تُشْبِهُ تلك الكَأْسَ/ يَشُقُّ الجُبّةَ مِنْها/ أَهْلُ القَفْرِ/ وأَهْلُ الفَقْرِ/ وأَهْلُ القَبْضِ/ وأَهْلُ الجَذْبِ».
وعبر استعارتها لمثل هذه اللغة في حضورها الصوفي العرفاني والإشراقي، تتجلّى الشاعرة لطيفة المسكيني بجراحات الذات وحيرتها وضيق الحال عندها، بل أنها تجد فيها الملاذ الآمن، وهو ما يلقي بظلالٍ من الرمز والإيحاء كثيفة في ديوانها «حناجرها عمياء». تقول الشاعرة: «هكذا بدأت الخطوات دربها وجاءتني/ بهمتها ممشوقة القدّ هذه الأسئلة/ قطعت الوتر اتبعت الوتيرة/ أطفأت وهجي الضال عن سبيلي/ تعال نتحول إلى قواميس تشبهنا/ يا هذا الطير!»، ثُمّ ينغمر أنا الشاعرة في إشراقات السكر وخدره اللذيذ، ويُقبل على مجهول الرؤيا وشطحها على ضفاف الكينونة المثلى: «أنت لست أنت أنا/ لست أنا هو ليس هو». تقول: «من سكري ما صحوتُ/ جنّتني ريشة الصراخ صمتُّ/ جنّني ريح الصمت صرخت/ جنّني وصف الصوت حضرت في المعاني وغبّ/ جنّتني الرؤيا شفعتها في وانصرفت/ يا رضا الصراخ في الصمت».
تستند الشاعرتان، أمينة المريني ولطيفة المسكيني، إلى لُغةٍ صوفيّةٍ إشراقيّةٍ تجلو وتغيم بحسب سياقات الحضور والغياب، فتجعل من ملفوظاتها معبراً نحو واقعٍ سامٍ ومحلومٍ به يتغذّى على مقامات الابتهال والرجاء والوصال والانتشاء الروحي والسعي إلى المطلق، وبه يستبدل واقعاً عيانيّاً مُؤْذياً ومرفوضاً. هكذا تتحرّر الذّات من حمأة الجسد ولعنته لتعانق عالماً آخر تهواه الروح وتسكن إليه، في معراجٍ روحيٍّ ونشيدٍ لانهائيٍّ يتدفّق بوعيها المتوتّر بأنّ في قلب المعرفة الصوفية تتلاشى هي نفسها تلقائيّاً لتنبثق محلّها وبديلاً عنها ذاتٌ أخرى أرحب تسع الكون فتفيض عليها ما يجعلها، تحت غمر المحبّة، تعيد اكتشافها والسفر فيها.
عبورات الجسد وتشهّياته
هذا الاشتغال، في تعُّدد مصادرها وآليّاته، على التجربة الجوّانية نلمسه يَطّرد عند شاعراتٍ أخريات، من مثل: فاتحة مرشيد، وأمل الأخضر، ونجاة الزباير، وصباح الدبي وإكرام عبدي، تمثيلاً. فهو يمتح من لغةٍ حسّيةٍ مُنْثالةٍ تعبر الجسد وتصغي إلى ظمئه داخل الفضاء النصي، ولا تتبرّأ منه. تقول فاتحة مرشيد في مقطع من ورقها العاشق: «ظامئ… / ألا فانْسَكبي / في مسامِ الرّوح/ زُلالاً / سأركعُ إجلالاً / فأنا من بَلدٍ / يُصلّي / للقطرات». أو: «أبسط يدي/ تربض الفراشات/ أفتح محارتي/ تتناثر الدرر/…./ عجين طين/ كنت/ شعاع نور/ صرت/ مُذْ لثمت أنفاسك/ شفتي».
ولا تظلّ أمل الأخضر حبيسة رؤياها المتشوّقة، بل تجعل تجربتها مع المطلق والعلويّ تتخفّفُ من جاذبية اللامرئي لرؤية جريحة ومغموسة في مشاهدات العالم الحسّي الذي يعبر جسدها، قبل أن يمتلكه أناها: «تجْرَحُني الرُّؤْيا/ تسيلُ مَدامعي دماً أَزْرَقَ/ ثُقْبٌ سَحيقٌ/ جُحوظٌ مَهُولْ/ العَالَمُ يَتَدلّى مِنْ عَيْني/ لا أَمْلِكُ رَدَّهُ/ لا يَمْلِكُ السُّقوطَ مِنْ غَيْري/ العَالَمُ خَفيفْ/ يَجْتَرحُ جسدي/ يَعْتَرضُ خُطايْ/ يَخْتَلطُ العَرَقُ بِاللُّعابِ/ أَشُدُّهُ.. يَشُدُّني/ تَرْتَعِشُ يَدايَ/ العَالَمُ أَنايْ».
وبأصابع غميسة في ماء الوجد وتآويله، تكتب نجاة الزباير حالات الذات في تعدُّدها، فتسكن إلى جسدٍ يُشيّد معناه في نشدان المعرفة، بوصفه رديفاً للجمال والخصوبة عندما لا ينغلق على كينونته المادية الضيقة، ويظلّ جماله المعنوي يتظاهر ماديًّا في الكائنات بما فيه الجسد نفسه الذي يتدثّر بجسد آخر ضدّاً على اندثاره في عالمٍ مَسْخ، كما في قصيدة «جسد آيل للصعود»: «في قوافيكَ تشظّتْ عافِيَتي/ أَرْفَعُ إِلَيْكَ جُرْحِي يَتيِمًا/ عَلَّ عَرَائِي يُبْعَثُ بَيْنَ أَنْفَاسِكَ/ فَيَصُدُّنِي إِفْـكُ اُلْوَقْتِ»، أو في قصيدة «جسدٌ ينقر أشلاء الصمت»: «لَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ اُلْغِـنَاءَ/ لَكِنِّي اُسْتَعَرْتُ صَوْتَ دَنَانِيـرَ/ لِأُضَاجِعَ لَيْلاً يَرْوِي ضَوْضَاءَ جَسَدٍ / اُنْسَابَ مِنِّي ذَاتَ أَبْجَدِيَّةٍ رَفَعَتْ حُجُبَهَا/ فَرَأَيْتُكَ مُتدَثِّراً بِهَوانا».
وفي معارج زاوجت بين شفوف الرؤيا ودفق الإيقاع، تصعد صباح الدبي لكتابة ذاتٍ مُجنّحة لا تهتمّ بالجسد إلا بمقدار ما يكون فيه مقاماً للكشف وطاقةً لتصعيد مكبوت القول الذي لا ينشدُّ إلى المندثر والمتلاشي منه، بلغةٍ لا تتخفّف من تجريديّتها إلا في لعبة المحو الذي تُجيده. إنّهُ جسدٌ متلألئٌ يبحث ارتواءه ومنابع ضوئه باستمرار في رحلة «معراجيّة»: «يُذِيبُ مَدَارُكِ ثلجَ مدَارِي/ ويُخْرِجُ بُرْجُكِ أنوارَ بُرجِي/ يا اشتعالَ التَّوَحُّد/ في عُشْبِ بَدْئِي/ تفوحينَ من/ زَهْرَة ِالمستحيل التي في شَذَاي/ طوتكِ المسافاتُ/ في رَوْضةِ القَلْبِ/ أَيْنَعَ صوتكِ في جنتي زهرة/ قبل بَدْئِي/ وقبل اشتعال مَنَارَاتِ مائِي وطِينِي/ فكنتُ/ وكنتِ السَّنَا فِي مُنَاي»، ثُمّ سرعان ما يعاني من الولادات غير المكتملة على طرفي الضوء والعتمة، ويضيق حتى يستحيلُ من السفر «رماداً» ببصيص نار.
وأمّا إكرام عبدي فهي تعاني تحوُّلات الجسد في تعدُّده وسيرته الزئبقية التي تنزلق في سلسلة دوالّ لا تنتهي، وذلك عندما يلتبس أنا الأنثى بأنا القصيدة، فلا تحسّ متى يبدأ هذا، ولا إلى أين يسعى ذاك. لكنّهما يتواطآن على الجسد الذي يتدفّق في نشدان المعنى، ويتخلّق باستمرار حالاته داخل حيّز الكتابة وإعادة الكتابة. تقول في نص «في البدء كانت أنثى»: «أيا امرأةً تتقمّصني/ ضاق جسدي بك،/ قصّي حبل المشيمة/ وامْضي…/ تيهي في براري القصيدة/ وانبجسي فكرةَ شاردةَ/ أغنيةً غجريّةَ/ واصنعي الإيقاع من صدى هذا الفراغ». إنّه جسدٌ غير مُحاصر، ومتفتّحٌ في أقاليم الليل المزدان بفوانيس الرغبة والاشتهاء. يُشيع حوله مساحاتٍ من طاقة العجب والرغبة والافتتان، وتسعى الأنا إلى البوح برغبته وبأنوثته الشرسة للآخر، لكن في دثارٍ من الغموض. وتبني إيمان الخطابي صور تخييل جسدها وفق أسلوب كتابتها الشذري الذي يتمفصل على متواليات بسيطة ومتدفّقة تعتمد التكثيف والتبئير والمفارقة، وهو ما تعكسه في ديوانها «حمّالة الجسد»، وفيه ينوء أنا الشاعرة تحت الجسد «الأثيم» وتشقى به، بل تسجن فيه، فيما روحها تتطلّع إلى أبعد من الجسد كما يتجلّى ذلك ملفوظاً ومُتقطّعاً في قصيدة تحمل العنوان نفسه: «لو أستطيع النفاذ بجلد روحي/ أترك لهم جسدي/ وأظفر ببعض الحرية/ في قفصٍ تربّى جسدي/ فلم تذهب بعيداً روحي».
في تحرير معنى الجسد
وتأخذ كتابة الجسد وتجربة عبورها السرّاني عليه مساراتٍ أخرى لدى شاعراتٍ، مثل: وفاء العمراني، وثريا ماجدولين، ووداد بنموسى، وإكرام عبدي، وفاطمة الزهراء بنيس، وعلية الإدريسي البوزيدي؛ وذلك عندما تنزل عن «معراج» الرُّوح وتتخفّف من التزاماته التي تستغرق الأنا بتجريديّة غامرة، وتنحو إلى سمت المادّية الذي تُحرّر به معنى هذه الأنا، وتُعيِّنه وتُسمّي حواسَّه ومغاليقه وعلاماته الهاجعة. وهو ما يستدعي، في الحقيقة، احتفاءً باللغة الشهوانية المفتتنة بنفسها وبالآخر بكيفيّةٍ تُطلق النزعة الديونيزوسية الولوع بأفراح الروح ومباهج الأنا بما فيها من رغبةٍ وبوحٍ وحميمية، بدون أن تسفَّ أو تنحدر إلى ابتذال. فهذه الشاعرة وفاء العمراني بوّأت الجسد، جسدها هي مفرداً ومُتعدّداً، مُتعيّناً ومحلوماً به، القدحَ المُعلّى في ممارستها الشعرية، عاملةً على التناصّ مع المرجع الصوفي الذي تُفجِّره صوتيّاً وجِناسيّاً من الداخل، لتتجاوزه برؤيةٍ لا تضادّية متسائلة تلعب في اللغة وتتسلّى معها وتُولّدها كما لو كان الجسد يفعل ذلك برغبوته ومرحه. تقول في قصيدة «مجد العري»: «هو الجسد الواجد المنوجد الوجد/ اللاقي الملقي اللقيا/ الرائي المرئي الرؤيا/ استوى الغجري على الملكوت/ انبسط الوعاء/ انكشف الستر/ انقبض الرهان/ لا الأين حد/ لا الكيف تعرف/ لا المتى مسلك/ لا الخلل سراج…». تصدع الشاعرة، هنا، بمادّية الجسد التي لا تقيم حدوداً، بل تحرص على تحريره من الكبت اللغوي والقمع الاجتماعي، وتعيينه بوصفه تجربة وجودية وكتابية في آن. ولقد تحوّل ذلك إلى استراتيجيّة في مجمل مجاميعها منذ «الأنخاب». بهذا الصدد تقول في قصيدة «نخب الجسد»: «أعلن اللغة عيداً بنفسجيّاً لروحي وأصرُّ على ملاحقة/ جسدي. انتشاء لهذا القهر المرتمي قرونا على أسيجتي».
وقد تستخدم الشاعرة أقنعة ورموزاً واستعارات حسّية، جسدية وخمرية، للتعبير عن شطح جسدها الكثيف، النضير والمُوجّل. وقد نجد شاعراتٍ غيرها من الجيل الجديد يستشهدن بأقوال المتصوّفة، أو يستخدمن العبارة الصوفية لحليةٍ نصّية وذريعةٍ تعبيرية للبوح برغائب الجسد وأشواق الذات، وهنّ يَسْتعِدْنَ هذه الصيغ في شعرٍ شذريٍّ قصير النفس، لهدف محض حسيّ، بل إيروتيكيّ إلى حدٍّ ما. تقول وداد بنموسى في نص «سكر»: «هذا أنتَ: داليةٌ/ هذِهِ أنا: عِنَبٌ/ هذا الحبّ: كأس نبيذ/ هذه الحياة:/ تسكر بنا». وتقول فاطمة الزهراء بنيس: «لِهَوْلِ ما رشفْتُ/ تَجمّرتْ شفتايَ/ هبني يا قِبْلة الروح/ ليلة قمراء أنغمسُ فيها/ حدّ التجلِّي/ كيف أَبْقى/ في ضوء/ خذلَ أُنْثايَ؟». وتقول ريم نجمي: «سماؤك عالية/ أنحني قليلا/ لأقبّلك/ سافرتُ فيك كثيرا/ ولم أصِلْ بعد/ إلى موقع الضّوْء.». وتقول علية الإدريسي البوزيدي في نص « مكاشفة»:»(…) إن لم يكن عندي نبيذ/ فعندك حانتي/ لتمارس/ إذن/ غيبوبتك!!». وتقول نادية القاسمي: «أنت علمتني/ كيف أصحو/ من النوم/ بالشكل/ الذي تبقى فيه/ صورتُك/ عالقةً/ كحلم هارب». فهنّ يستثمرن مفردات التصوّف (سكر، صحو، أبصرتني، قبلة الروح، التجلّي، السفر، مكاشفة، غيبوبة..)، لكن لغرض جسديٍّ وشهوانيّ مُناقض لروح التصوُّف وجوهرانيّته بحسب رؤية كلّ منهنّ ولغتها.
وتأخذ هذه المفردات لَبوساً إيحائيّاً ليس مفرطاً في التأويل، إذ هي تنفتح على تلويناتٍ وتصادياتٍ من المعجم اليومي تسعف ذات الكتابة في نقل تجربتها بعفويّةٍ، بدون وسيطٍ لغويٍّ كثيف. إنّهن يُصغين لدبيب الجسد ونداء حواسّه المباشرة، بل يتّخذن الجسد مرجعاً لغيريّة مفترضة، وذريعةً لفضّ قيد الحرية على قولهنّ الأسير، وجسدهنّ الحسير.
هكذا يتحوُّل الاحتفاء بالجسد في الكتابة عند أنا الأنثى من جسدٍ سكران مُنْتَشٍ يتوهّج في المطلق والعشق الإلهي والمعرفة والجمال، قبل أن يغيب أو ينطفئ، إلى جسد فرح بكينونته الضاجّة بطاقة الحياة وكوامنها، فيصير نتيجةً لذلك بؤرةً تتّقد فيها مشاعر الأنثى ورغابها الفياضة، أو جسدٍ ثائر ينسج دوالّه من مُتخيّلٍ ينشد الخلاص والحرّية.